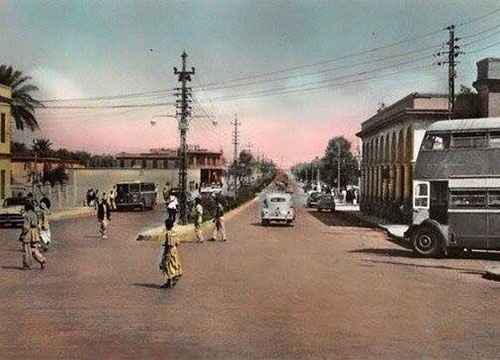على غير عادته كان بائع التمر متسامحا هذه المرة، طلبت منه ان يجلب كمية من تمر “ التبرزل” الذي آسرني بطراوتة ونضجه المبكر. غادر البائع على الفور لجلب هذا النوع الذي تغنى به الشاعر النواب بقوله” فوق التبرزل طعم”. غير إن نظرة جانبية غيرت المعادلة، حين جذب نظري الشكل الهرمي للعذق المركون قريبا مني،كانت شماريخه تضج بكرات بلون الكهرمان الأصفر المتوهج النضوج بلمعان خجول،إنه البرحى ذلك النوع الذي خفق له قلبي،عدلت عن شراء النوع الأول وخاطبت البائع :
- ضع لي خمس كيلوات من البرحي،ان هذا النوع يتمتع بحلاوة باردة،وهو أقل ضررا لمرضى السكري.
لم ينبس البائع ببنت شفة ،مما شجعني أن أمد يدي وأنتقي بعض الثمار الناضجة،لكنه كان أكثر حرفية عندما جلب قاطعة ميكانيكية وراح يقطع بها الشماريخ،التي صدرت عنها أصوات تطرب لها الأذن... قرط... قرط... قرط... ،نقدته ورقة العشرة آلاف دينار،كانت جديدة،خضراء ترتسم على وجهها صورة العالم العربي الجليل الحسن بن الهيثم وبجانبه تتقاطع خطوط نظريته في الانكسار الضوئي.
عندما اقتربت من الحافلة الصغيرة من نوع كيا، احتل آخر راكب موقعه،صعد السائق وراء المقود وراح يدوره بنشوة،وهو يشير اليّ بعدم وجود مقعد شاغر،ابتسمت بوجهه قائلا : نلتقي غدا،توجهت الى مستطيل الظل الذي لا يكاد أن يفي لوقاية ربع جسدي من هجير سلق العالم برمته. لم يمض وقت طويل حتى قدمت حافلة أخرى متهالكة. المشكلة الآن في توافر الركاب، صعدت امرأة شابة بثياب سود،جلست قرب النافذة ،أشرت اليها ان تجلس بعيدا عن النافذة ،وأنا أقول لنفسي ...اللون الاسود يمتص الحرارة ...،ابتعدت المرأة عن النافذة، شاغلت نفسي بالحديث مع بائع صغير السن لقناني المياه،كان صغيرا بسمرة طاغية وبوجه له لون حبات القهوة المحمصة ،اقتنيت قنينة ماء بارد لنفسي،وقدمت واحدة للمرأة وأخرى لشاب في مقدمة السيارة. أنهيت قنينة الماء على عجالة، ودسستها في الفراغ الصغير الذي يسمح به كيس خلل البرحي، حدق البائع الصغير نحوي بدهشة وهو يقول :
- عمو ،طَوّح بها هناك مع تلك القناني .
- أنا معتاد على ذلك، ما أن أصل البيت حتى أضعها في الحاوية المخصصة للنفايات، وأنا أنصحك أن تطالب بتوفير حاوية،بدلا عن هذه الفوضى .
في هذه الأثناء قدم والد الصغير، وراح يعد القطع الورقية من الفئات الصغيرة، مبديا شعورا بالراحة، غير إني بادرته :
-لا تفرح بهذه الملاليم يا أخي، من حق هذا الصبي أن يهنأ بتعليم أفضل وملاعب تسعده.
قاطعني صوت الصبي الصغير بصوت واثق :
-أخبرهم يا أبي أن يضعوا حاوية للقناني الفارغة.
ارتسمت أكثر من علامة استفهام على وجه الأب، ولكن حبورا طيبا نزل على قلبي مثل مياه القناني الباردة التي شربناها، أنا والمرأة الشابة، والشاب الذي يجلس في مقدمة السيارة.
تقاطر الركاب على الحافلة المتهالكة، ومن دون اعلان صعد السائق، كان معافى وبغطاء رأس داكن، جمعنا الأجرة كعادتنا، وبلا مناسبة، شق صوت السائق السكون الملتهب بحرارة خانقة وسط زحام لاينتهي،والذي كان يتلوى مثل أفعى أناكوندا سوداء عملاقة :
-باب المصخم .... باب المصخم.... باب المصخم....
ساد الصمت، لم يرد أي راكب، لكني لم أطق صبرا.
- بدون زحمة ماذا تقصد بكلامك؟
- قابل كفرنا !!!
- لم أقل إنك كفرت، لكنك أسأت إلى جزء عزيز من وطني.
قلت ذلك بكلمات هادئه خالية من أي أثر للإنفعال، فيما راحت الصور تترى على مخيلتي لأكثر من عشرين عاما .... في مقهى الملتقى الثقافي تداولنا الكثير من القضايا الثقافية، لكن المقهى أغلقت بحجة الصيانة، غير اننا جميعا كنا نعرف إن السبب الرئيس وراء ذلك كان المراقبة الرسمية المفضوحة لأفراد يرتدون الزي الرسمي مع أجهزة موبايل لا تكف عن التقاط صور لشخصياتنا المهمة جدا !! ولم ينقطع معظمنا من المرور أمام المقهى الموصودة الأبواب للنظر عبر الكوى الصغيرة عسى أن يكون صاحب المقهى قد أنجز الصيانة أو عدل عن فكرة غلق المقهى. على مبعدة دقائق قليلة، تقع الكلية التي درست في أماسيها الفاتنة أربعاً من سنوات عمري، ولم يسبق لي أن تأخرت دقيقة واحدة عن الحضور اليومي،من وحيها كتبت قصتي الأولى بعد انقطاع طويل عن الكتابة بعنوان “خيبة” أهديتها إلى الشاعر الانجليزي وليم بليك وقصيدته الرائعة “The Tiger “ وكان المفروض أن أهديها إلى استاذ مادة الشعر،الذي كان يسحرنا بمجساته النقدية الفنية،عندما يقوم بعرض القصائد وشرح خفاياها الجمالية، لكني خشيت عوامل الغيرة والحسد وعوامل أمنية أخرى، خاصة من قبل أستاذ المسرح الذي تقصد حجب المعلومة عني بطرائق ساذجة،وفي إحدى الأماسي صحبني في جولة في ممرات الكلية وهو ينتقل من موضوع الى آخر، أخيرا سألني : ما رأيك بفلان وفلان وذكر اسم الناقد طراد الكبيسي، عرفت أنه يحاول الايقاع بي،قلت له لا أعرف الأسماء التي يتحدث عنها، وعند مرورنا قرب حاجز أمني، خمنت أنه على وشك أن يسلمني اليهم،لكنه عدل عن ذلك في اللحظات الأخيرة، وعندما اطلع على نتيجتي الدراسية وكنت قد أحرزت المرتبة السادسة بين زملائي الاعزاء في القسم، قال لي ببرود والأسف يقطر من كلماته : يمكنك أن تكمل دراسة الماجستير....وقضيت ست سنوات من عمري مترجما في وزارة التربية، كنا نرتقي سلالم الدائرة في بناية قديمة تقع مقابل دار الحرية للطباعة والنشر سابقا، لنجتمع في غرفة صغيرة برفقة طيبة، ونادرا ما نترك الغرفة لنتحين الفرصة للنظر إلى مقبرة الجنود الانكليز الذين قضوا في الحرب العالمية الأولى، والتي تمتد أمامنا بمهابة وتنظيم دقيق، وفي وسطها تنتصب قبة ضريح الجنرال مود قائد الحملة، الذي قضى بسبب كوب حليب ملوث بمكروب الكوليرا.
ولي في مكاتب الاستنساخ حكايات وحكايات، كانت أولها اصدار كتابي الأول بعنوان “ الأطفال كممثلين في العصر الاليزابيثي” وكان باللغة الانكليزية، أتذكر انني استنسخت كما كبيرا من النسخ، كنت في حالة من النشوة، وكأني غير مصدق بأني سأطبع كتاباً يحمل اسمي، أخيرا ظهر الكتاب بغلاف سميك مزيناً بصورة أخذناها عن مخطوطة لجرة رومانية لأطفال يؤدون أدواراً درامية. لقد دفعني هذا النجاح أن أطبع ديواني الشعري الأول “من ضفة لأخرى، قصائد ووسائد”،زينت الديوان بتخطيطات صديقي “حمادي” الفنان العالمي الراحل، ولم يثر الديوان ضجة أدبية، كتبت عنه دكتورة على الفيسبوك مقالة ممتعة، وهي تقول انك لا تكتب بقلمك بل بقلبك،وكتبت عنه محررة في جريدة الصباح الجديد،و كتب شاعر مشهور مقالة جميلة، ولا أنسى تظهير الكتاب الذي كتبة ناقد مشهور،لم أكن أحلم بأكثر من ذلك فالساحة الثقافية تحكمها عوالم سرية لا يمكن الولوج اليها بيسر. تعاملت مع العديد من المكاتب، لكن الذي حيرني ما جرى لي في مكتب الصادقين ،كان صاحبه شاب بجسد ممشوق، وكنت أطبع في مكتبه بإفراط يومي، وفي أحدى المرات استأذن ان يذهب إلى مكان ما ويعود،عاد فعلا، وبعده دخل شاب ثلاثيني مفرط العناية بهندامه ليوجه من دون مناسبة خطابه نحوي مباشرة :
-والله اشتريت لأبنتي عشرين كتابا من معرض الكتاب.
دق جرس الانذار في أذني، بالأمس فقط كنت في معرض الكتاب.
- ما هو رأيك استاذ ؟
- عفوا، لا رأي لي، انها مسألة خاصة بك.
حاول صاحب المكتب الدخول على الخط، استأذن الشاب الأنيق مغادرا وبعد لحظات غادرت وأنا أحث الخطى إلى داري.
ولا يمكن أن انسى محل أخي، الذي فتحه لمعالجة المواطنين ووضع في الشارع المقابل له يافطة بحروف كبيرة “ المعالج الباراسايكولوجي “ وشَغّلَ عاملا نزيها كان بدرجة معاون مدير عام أحال نفسه الى التقاعد أيام الحصار،لكنه لم يمد يده إلى الأملاك العامة أو الخاصة، بوظيفة “ كاظوظ”،الذي كان من واجبه جلب الزبائن الى محل الباراسايكولوجي، علق أخي على الجدار مقالات صحفية تشيد بقدراته،وصور لنجوم عرب وعراقيين،من بينهم الفنان المصري سمير غانم الذي أعجب بطريقة العلاج وقال إنه سيصحب زوجته الفنانة دلال عبد العزيز لتسكين ألام مفاصلها في الزيارة القادمة الى بغداد. وكان العديد من الزبائن يتلقون العلاج على يديه،وهو يغمرهم بطيبته وحين يغادرون كان هناك شعور صادق بالإمتنان يشع في عيونهم،وقد وصل به الأمر أن يقوم بمعالجة عدد من الأطباء لحالات عجز من علاجها اطباء تخرجوا من الأكاديميات الطبية.
أشعر بالمودة لخطواتي على كل رصيف من أرصفته التي لا أستطيع وضع حدود لها،بل اني أعرف اصحاب المحال التجارية وأكشاك الخضروات وأحواض الأسماك الحية وهي تمخر في المساحة المائية الضئيلة المخصصة لها،وباعة الصحف الطيبين الذين يمكن ان يتحولوا الى محللين سياسيين أكفاء في أوقات الذروة السياسية،وما أكثرها ،والصغار باعة أكياس النايلون،الذين يتوسلون المتبضعين لشراء أكياسهم الملونة. الجميع يعيشون مع أنفاسي ويصاحبون رحلتي التي تتغير خريطتها كل يوم،ولا يمكن لي الا أن أرد فضلهم عليّ،فكيف اسمح لسائق الحافلة المتخفي بغطاء الرأس الداكن أن يشتمهم،ويشوه الذكريات التي لا تمحى،شعرت بالراحة بعد أن أفلست حجته.
لم يحر سائق المركبة جوابا،تشاغل بإزاحة غطاء رأسه الذي حجب الرؤية عن عينيه،رفعه إلى رأسه ثم شمر نهايتيه على كتفييه وراح يقود حافلته المتهالكة بتثاقل،نظرت إلى كيس خَلال البرحي ذات اللون الكهرماني الضاحك والقنينة الفارغة في وسطه،التي راحت تتصافق مع الشماريخ المحملة بالخَلال ،وهي تصدر أصوات خافتة مع كل استدارة مفاجئة.