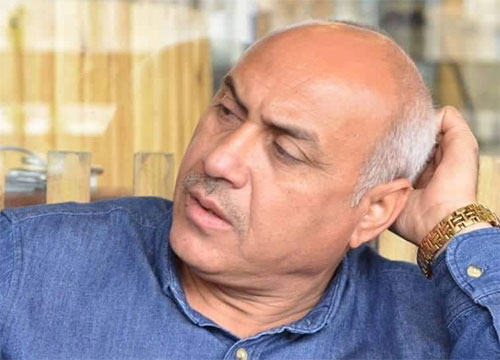أن تنشأ في زمن حضاري بعينه نشأة طبيعية فليس أمامك سوى الاستجابة لمقتضياته، والاستجابة لمنطق العيش فيه. وقبل هذا وذاك ليس أمامك سوى الاستجابة لأنساقه الثقافية ونبضها، وأن تسلك طرقه وأن تنظر بعينه التي يرى فيها العالم. هذا ما حصل للنقد الثقافي، حين وجد نفسه في عالم مابعد الحداثة. فحياته تقتضي الالتزام بتوجّه العصر الذي هو فيه. بل الأمر يتعدى مسألة القناعة والالتزام، فمنطق العصر يطلب من النقد الثقافي بصيغة تشبه طلب الأب من ابنه، فهو طلب كالأمر. فلولا عالم ما بعد الحداثة لما نما النقد الثقافي هذا النموّ، ولما أزهر وصار له شأن وحضور.
في عالم ما بعد الحداثة حكمَ قانون (دعه يمر) عابرا الحدود، وتمددت سطوة العصر بقانونه هذا على مفاصل الحياة ،وكل قطاعاتها وحقولها، كالاقتصاد والسياسة والفنون، فانفتحت الحدود وتمدد التأثير والتأثّر. وفي الدفقة الحضارية اللاحقة ((بعد ما بعد الحداثة)) ومنذ تسعينيات القرن العشرين صار العبور والتداخل أشد وضوحا وأكثر تعقيدا، حتى سُمي بأنّه العصر التشاركي.
لو أمعنا النظر في الفنون لبدت لنا فنون المعمورة وقد تداخلت، ولم تعد الحواجز والحدود قائمة بصلادة وقوة، وصار عبورها سهلا، وقد تحقق عبورها في الواقع بصورة جلية، من حيث الجغرافيا ومن حيث التداخل في نوع الفنون. والأمر في الأدب جليّ هو الآخر، حيث تداخلت أشكال النصوص وعبرت الحدود على بعضها، بصيغ متعددة ونسب متنوعة بحسب وعي الأديب بروح العصر وغايته الفنية، حتى ولّدت في النهاية نصّا مفتوحا. ورفع العصر عصاه على الحدود الفاصلة بين الرسم والأدب، فوُلدت ((القصورة)) معبّرة عن علاقة بين الصورة والقصيدة، فلا هي صورة خالصة مستقلة مكتفية بالألوان والخطوط، ولا هي قصيدة خالصة مكتفية باللغة. ثم دعا الشعر ليعقد قرانه على الموسيقا مستفيدا من تكنلوجيا العصر وعالم الإلكترون، فوُلدت القصيدة التفاعلية، ليجد فيها المتلقي اللغة مع الموسيقا بحضور المتلقي فاعلا، وبحضور تكنلوجيا الحاسبات مؤدية الدمج ببراعة.
هو عصر موسوم بمحاربة الحدود ودائم التحريض على العبور، فكيف للنقد الثقافي أن يُدير ظهره لكل هذا؟! أو أن يعصي أمر العصر الذي رعاه فأزهر فيه مستجيبا لقوانينه واشتراطاته؟! هذا لن يكون بلا شك. والأمر يتجاوز مسألة طاعة الابن لأبيه إلى أمر آخر، هو أن هذا الابن بأمسّ الحاجة إلى هذا العبور، بل إنّه أصلا غير قادر على العيش والنمو داخل أسوار تحميه وحدود توضع له.
فالنقد الثقافي بفضائه العام يشتغل على كلّ مُنتَج أسهمت الثقافة في وجوده. وهو في فضائه الخاص بالأدب يشتغل على النصوص الأدبية التي أسهمت الثقافة في ولادتها على هذا النحو وبهذه الهيأة. هو، إذاً، ابن عصر الذي يدعوه ليلا ونهارا وهمسا وجهارا إلى العبور. وهو من جهة أخرى يشتغل في منتجات الثقافة، التي هي أصلا تهزؤ بكل الحدود، ومتغلغلة في كل شيء وعابرة لكل شيء. فمثلما هي في الأدب هي في الموسيقا حيث ثقافات الشعوب مغروسة في آدابهم وفي موسيقاهم. وهي حاضرة في أشكال العمارة، وفي طريقة طبخ طعامهم وطراز ملبسهم... هي في كل شيء لا تحدّها حدود، ولا تقف بوجهها أسيجة لتقول لها لا تَلِجي هذا الحقل ومسموح لك بذاك. الثقافة أكبر من أن نمنع وجودها من أيّ مكان، أو أن نسيّجها بسياج لتبقى في حقل دون غيره. هي كالشمس حين تُشرق تبعث ضوءها إلى كل مكان، وإن شئنا دقة التشبيه في الولوج إلى كل شيء، فهي كالظلام الذي يغطي كل شيء، الجبل والكهف.
النقد الثقافي، عصره يدعوه إلى العبور، وهو ويعمل في حقل يدفعه إلى العبور، فمنتجاته ثقافية محرّكها الثقافة العابرة لكل الحدود، لاسيما في هذا العصر الذي صارت التكنلوجيا ووسائل تواصلها الاجتماعية تتحدى كل حدود، وتقتحم كل مكان، وكل مجتمع، وكل عالم من العوالم. والنقد الثقافي وهو يؤدي مهمته في الدرس والتحليل والمساءلة؛ يكون مُلزما أحيانا بتخطّي الحقول المستقلة إلى العمل في مساحات بينيّة، رمادية اللون، لا هي لهذا الحقل خالصة الانتماء ولا هي لذاك الحقل منتمية. وهنا الموضوع أصلا متحقّق فيه العبور بسبب الثقافة. فثمّة نصوص على النقد الثقافي أن يَلِجَها ليبحث في مسألة ثقافية تغلغلت فيها، ويجدها نصوصا في أصلها عابرة للتخصص. فقد يجد نصا تاريخا مكتوبا بلغة أدبية، وقد يجد أدبا تضمن تاريخا... وقل الشيء نفسه في علاقة الأدب بالفلسفة والانثروبولوجيا، أو في غير هذا كلّه.
فثمّة ما يدفع بالنقد الثقافي إلى العبور دفعا، وثمّة ما يجرّه إلى العبور جرّا، وكلاهما في الآن نفسه. وما عساه أن يعمل في مثل هذا الحال سوى الاستجابة؟! لكنه والحق يقال، في الأصل لم يكن ممانعا لفكرة العبور. بل هو يريده، وهو مغروس فيه ولا يجد ضيرا في أن يجد العبور جزءا أساسيا في نظامه. لذا استجاب النقد الثقافي لمبدأ العبور ليكون قانونا من قوانين اشتغاله المنهجي. وصار يستعين بأكثر من منهج، بحسب الأسئلة التي يطرحها عالم النقد الثقافي، وصار الناقد الثقافي باحثا متمرسا بإدارة الآليات والإجراءات المنهجية التي يحلّل من خلالها ويجيب على الأسئلة من خلالها. وصار يعبر حدود المناهج النقدية بلا استئذان، فيأخذ منها ما يشاء ضمن الرؤية المنهجية التي تبلورت لديه، من خلال مراسه في التحليل النقدي ومعرفته بالمناهج. فالناقد في النقد الثقافي ((مدير متمرّس)) بإدارة المناهج، وليس تكامليا قد توجهه المصادفات أو حتى العواطف، بل مدير مسؤول، و كالمحقق في قضية جنائية، لديه أسئلة مطروحه في النصوص يكتشفها برؤيته وتحتّم عليه مسؤوليته أن يجيب عنها بأعلى قدر من الموضوعية وبصنعة المحترف الماهر، ولديه هدف يريد الوصول إليه، ولن تمنعه حدود أو تقف بوجهه أسيجة، لذا يبقى مبدأ ((العبور)) لديه؛ منطق متجذر في بنيته، وحاجة حياة، واقتضاءً طبيعيا غير مفتعل.