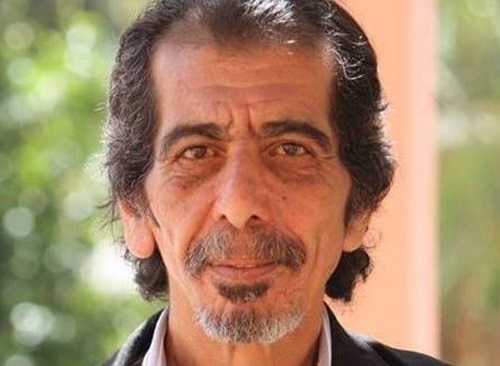يأخذنا كتاب الناقد فيصل درّاج “كأنْ تكونَ فلسطينيّا: شذرات من سيرة ذاتية” (إصدار المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 318 صفحة)، في رحلة تمتد ما يقارب ثمانين عاما، هي عمره المديد، الذي يبدأ بولادته في قرية الجاعونة- صفد، في عام 1943، وما إن يبلغ الخامسة حتى تكون نكبة عام 1948 قد حلّت، وجرى التهجير، فننتقل معه وأسرته إلى أول قرية لجوء سورية، ثم إلى دمشق التي سيدرس في مدارسها الابتدائية و”التجهيزية”، قبل أن يدخل جامعتها ليدرس في قسم الفلسفة، ونرحل معه إلى باريس لاستكمال دراساته العليا، وإلى عدد من العواصم العربية والدولية بدوافع ومبررات شتّى، غالبيتها ذات طابع ثقافي، والالتقاء بعديد المبدعين من عوالم مختلفة، كتّابا وأساتذة... وصولا إلى اليوم وما يجري في غزّة وفلسطين عموما. وبسبب تعدد الموضوعات والمحطات والمسارات، سنختار التوقف عند أبرز ملامح هذه السيرة.
في إطار هذه الخريطة الواسعة، زمنا وأمكنة، من الذكريات والتأملات والتنظير لبعض المفاهيم، تعمل ذاكرة درّاج في غير اتجاه على صعيد الموضوعات، وتعدد أساليب “التذكر” من سرد للحوادث والوقائع وتفاصيل متعلقة بأشخاص، ومن تأملات في هذا كله. والأساس في عمله هو أنه مهجوس بتعيين “هوية” اللاجئ الفلسطيني وتعريفه نسبة إلى من يملك وطنا وهوية واضحين... لذا فهو ينهي كتابه بجملة شديدة الوضوح في تعريف الفلسطيني، وبقدر من التشاؤم، ربما كان طبيعيا، يرى “أن يكون الإنسان فلسطينيا يعني أن يدرك أن نكبته الأخيرة ليست بأخيرة”، وأن “في أحزان غزّة حكايات متداخلة تنتظر الكتابة... وهي لا تزال تنتظر النهاية وبداية أخرى”. وتجدر الإشارة إلى عبارة تمثل انزياحا عن العنوان وهي “كأن تظلّ فلسطينيّا!”.
أن تكون فلسطينيّا
تتداخل في هذه السيرة موضوعات وحكايات كثيرة، قصيرة وطويلة، وأساليب سرد تبلغ حدود الرغبة في كتابة القصة، هذه الرغبة التي بدأت مع المؤلف في وقت مبكر، لكنها لم تنجح، كما يقول، وها هو هنا يسرد تجاربه ومشاهداته في نصوص يصلح الكثير منها لأن يكون في باب القصّة. إنه “حكّاء” يمتلك أدوات السرد الأساسية، واللغة الملائمة، منذ تقديمه “سردية” قريته مسقط رأسه، ومتابعة مع حكايات الهجرة القسرية إلى قرية سوريّة موزعة بين الشركس والتركمان، وانجذابه إلى البعض، ونفوره من البعض. وتوزيعه أدوار السرد على صوتين يتداخلان، هو وأنا، كان وكنت، بفقرة واحدة. يقول عن نفسه: “الفلسطيني الذي هجّر في الخامسة يكتب سيرة ما عاشه بعد الوطن”، ويتساءل: “لمذا أصبحت لاجئا؟”، و”كيف يتكون الإنسان لاجئا في عالميه الداخلي والخارجيّ؟”، ويهبّ الحنين في ذاكرة “الصبي المهاجر”!
وضمن مشروعه لتعريف معنى أن تكون فلسطينيا، فهو يعود ويؤكد أنه يعني “أن تحتفظ ذاكرته بما عاناه في المنفى، ألّا يسقط في إقليمية خائبة تنكر العرب والعروبة؛ ألّا يقدس قياداته القائمة أو المؤجلة؛ أن يدرك أن القدَر الظالم نشر الفلسطينيين في شتات لا حدود له؛ وأن يرى الثقافة في القيم والأخلاق واحترام الأعراف والتضامن القائم على العقل والمساواة، وأن الثقافة الفلسطينية تمتد من مظاهرات القدس العارمة ضد الانتداب البريطاني ووعد بلفور عام 1920، مرورا بعزّ الدين القسّام وثورة 1936، وانتفاضة النساء العظيمة عام 1987، ووصولا إلى طوفان الأقصى وبطولة غزّة الخالدة”.
تحتل هوية اللاجئ الفلسطيني ومشاعره، حيزا مهما في هذا الكتاب، فهي محور أساس تبدو منذ العنوان، وتبدو في استخدام كاف التشبيه في “كأنْ تكون” ولم يقل “أن تكون فلسطينيا”. يتعلق الأمر هنا بما يشعر به هذا اللاجئ من مهانة واغتراب ونقص الأمان، حين يتعرض، في المطار، للسؤال عن أصوله، ويُطلب منه الانتظار، ويشعر بالإذلال حين يسمع أحدهم يتهم الفلسطينيين بالهروب، وأكثر من ذلك أن يتهموه بأنه باع أرضه ووطنه وهرب وجاء إلى وطننا؛ “لو كان فيكم خير ما تركتم بلادكم وأتيتم إلى بلادنا... ولو كنتم تعرفون معنى الوطن لدافعتم عنه”... بهذا المعنى يغدو اللاجئ عبئا حتى على إخوته وأهله المقرّبين. لكن في المقابل ثمة من يقرّبه ويحبه ويدافع عنه. ويذكر درّاج أن الرئيس الشيشكلي أصدر قرارا بمعاقبة كل من يسيء إلى لاجئ فلسطيني، عقابا يتضمن السجن.
ثقافات ومبدعون عرب وعالميون
في الثقافة العربية، يحتفي درّاج بأسماء وتجارب عدة، أعتقد أن على رأسها الروائي عبد الرحمن منيف والمسرحي السوري سعد الله ونّوس، والروائي الأردني غالب هلسا، ولاحقا الروائي الأردني الياس فركوح. وعدا هؤلاء، سوف نقرأ عن علاقته بكل من إحسان عباس ومحمود درويش وعز الدين المناصرة، والمقارنة بينهما، وينقل عن درويش شهادة إيجابية حول تجربة المناصرة يقول فيها: “أعتقد أن فلسطين أعطت شاعرين كبيرين، رحل إبراهيم طوقان مبكرا، وبقي عز الدين، وهو ظاهرة شعرية فلسطينية كبيرة. إنه أهم ما عندنا اليوم... كنت أتمنى أن يكون واعيا، أكثر، لمشروعه الشعري”. كما سنقرأ عن تجربته مع أنيس صايغ ومركز الأبحاث ومجلة “شؤون فلسطينية”، وكلها تجارب وعلاقات تأتي في سياقات ثقافية- سياسية، هو الذي عرف الثقافة ولم يتعمق في العمل السياسي، خصوصا الفلسطيني، لسبب يتعلق- ربما- بما تتصف به من “دنس” وبعد عن الأخلاق التي يقدسها.
في فصل “وجوه مدينة دمشق” تبرز علاقته مع ونوس ومنيف، ويتوقف درّاج عند تجربة ثقافية مهمّة جمعت ثلاثتهم، وهي إصدار “مجلّة في كتاب” تحت عنوان “قضايا وشهادات: كتاب ثقافي دوري”، فيكتب عنها “حين جاءت إلينا فكرة الكتاب الذي أشرفنا عليه بحثنا عن عنوان متقشف لم تستهلكه المجلات العربية: الطليعة، المسيرة، التقدم، النهضة، وغيرها من عناوين”، ويضيف أنه كتاب يتناول “قضايا العالم العربي الذي يتقهقر عما كان عليه قبل مائة عام، وشهادات تدل على أن ما سنقوله قال به غيرنا، وسقطت أقوالهم في المزايدات الأيديولوجية... أراد كتابنا أن يكون ذاكرة للفكر النهضوي الذي أُسقط ولم يسقط”. وللأسف لم يعمّر هذا المشروع النهضوي أكثر من أربع سنوات.
في عام 1974 وصل درّاج إلى بيروت، بحث عن مكتب مجلة “الطريق”، وفيه التقى نزار ابن حسين مروة، وشعر بالجو الماركسي شبه التقليدي، ثم توالت لقاءته مع مروّة الأب، ومحمد دكروب ومهدي عامل، بأسمائه الثلاثة، مهدي عامل للفكر والتأليف، وحسن حمدان لتلامذته في الجامعة، وهلال بن زيتون، يوقع به قصائد متأملة يكتبها بعد عناء النهار... يقول مهدي “أمارس النظرية نهارا وأكتب الشعر ليلا”. وفي المجلة سيلتقي الناقد محمد دكروب “سمكريّ الأدب” وتبقى صداقته معه حتى وفاة دكروب.
“تحتل هويّة اللاجئ الفلسطيني ومشاعره، حيّزا مهما في هذا الكتاب، فهي محور أساس تبدو منذ العنوان، وتبدو في استخدام كاف التشبيه في “كأنْ تكون” ولم يقل “أن تكون فلسطينيا”. يتعلق الأمر هنا بما يشعر به هذا اللاجئ من مهانة واغتراب ونقص الأمان”
وفي بيروت سيلتقي بالتأكيد مع فنان الكاريكاتير المختلف ناجي العلي، في جريدة “السفير”، وسيقضي بصحبته، مع آخرين، أياما في أثناء اجتياح جيش الاحتلال الصهيوني لبيروت، ويكرر عبارة ناجي الشهيرة “أولاد الشلّيتة”، وهم “الذين يسخر منهم برسومه ويعرّض برذائلهم غير المقتصدة بلا اقتصاد”. ويرى فيه الفنان والإنسان “البسيط الكلام واللباس، الأليف الحضور”، ويقول: “تحالف ناجي مع براءته، كبر معها وصاغت تفاصيله، حماها واحتمى بها، وظنّ أنها تكفيه وتطرد الأذى. أنهت رصاصات النفوس الموتورة حياة ناجي، ولم تنهِ رسومه”. ولم يقل درّاج “رصاصات الموساد” مثلًا، فمن هم أصحاب “النفوس الموتورة”؟ ويذكر أن سعد الله ونوس طلب من ناجي أن يسمّي له عشرة من “أولاد الشلّيتة”، فرد عليه ناجي: “اتقّ الله يا رجل، عشرة منهم يهزمون قضية عادلة، وأنا مجرد رسّام فقير من مخيم عين الحلوة”.
وعربيّا أيضا، يتوقف درّاج عند عدد كبير من المبدعين العرب الذين ربطته بهم علاقات متفاوتة في العمق، تستوقفنا من بينها علاقته بالكتّاب المصريين، صنع الله إبراهيم وجمال الغيطاني و”الأستاذ” نجيب محفوظ في عوامة على النيل. ومن بين هذه العلاقات، تستوقفنا علاقته بالغيطاني، وقد شدّتني لقطات من كتابته عن رواية هذا الأخير “الزيني بركات”، ولقاء وحديث في دمشق وخلاله يسأل درّاج الغيطاني عن شخصية “التلميذ” في هذه الرواية، التلميذ الذي أفزعه بصاصو السلطة الحاكمة فيصرخ “اقتحموني وهدموا أسواري”، في إشارة إلى اغتصابه من قبل السجانين. يسأله عما حلّ بالتلميذ، فيجيبه: “إنه أمامك، دخل السجن وخرج منه وكتب رواية عن المستبد برأيه”.
أما عالميا، وفي باريس تحديدا، فيكتب درّاج عن شخصيات مرموقة في الثقافة العالمية، قابلهم أو تلقى دروسهم مثل ألتوسير. ومن بين هذه الشخصيات يبدو معجبا بالشاعر والمسرحي المتمرد جان جينيه، الذي ارتبط اسمه بالدفاع عن فقراء من المغرب، وعن سود في أميركا يسعون إلى حقوقهم المدنية، وفلسطينيين وزّعهم الاستعمار الغربي على شتات... وهو صديق النضال الفلسطيني، وصاحب “ساعات في شاتيلا” و”الأسير العاشق”، وغيرهما. يكتب درّاج: “سألته: لماذا تقف إلى جانب الفلسطينيين؟”، أجاب: “أنا أقف إلى جانب الحق الذي سُرق من الفلسطينيين الذين حرموا ظلما، من حقوق إنسانية متعددة. إنهم سجناء في خيامهم، وأنا كنت سجينا، سُرقت حقوقهم جهارا في منتصف الظهيرة...”.
وفي التفاتة نبيهة، يكتب درّاج عن ظاهرة الملصق، يتساءل أولا: “لماذ أصبحت مفردة الملصق من مفردات الفلسطينيين السائرة؟”. ويجتهد لإيجاد أسباب عدة، أولها الإعلان عن ميلاد جبهة انفصلت عن أخرى تنقصها الثورية، أو الاحتفال بتأسيسها بعد مرور عام، وتذكير بوقائع فلسطينية يجب ألاّ تموت، تستهل بالمجازر وتنغلق بمجازر أخرى، والسبب الأكثر شيوعا نشاط وطني توّج بالشهداء. ولا ينسى الإشارة إلى جدران شارع ابو شاكر (الفاكهاني) التي تعج بالملصقات.
وقبل الختام، هنا وقفة خاصة بعلاقة درّاج مع “إحسان عباس: إنسان من معرفة وبصيرة ومحبة”، فهو يبدأ حديثه عنه بحديث عن كتابه الشهير “غربة الراعي- السيرة”، ويقرأ كيف يقف عباس في استهلالها على مزبلة القرية حيث يقول: “لو كان ذلك الطفل في ذاك الزمان يعرف معنى الرموز لأدرك أن جميع طرق الحياة تفضي إلى مزبلة”. ويعلق دراج: “عباس هنا يصادر الاستهلال السيرة ويجعلها صفحة بيضاء، ذلك أنها قالت ما تريد من السطور الأولى”. يقول: “ارتبطت صور الراحل د. إحسان عباس بذاكرتي بمناسبات ثلاث: زيارتي الأولى منزله، القريب من حديقة الصنايع في بيروت عام 1978. وحضوره الأنيس في لجنة تحكيم جائزة القاهرة للرواية العربية عام 2002، وكان الراحل رئيسا. وصورته في شرفة منزله في عمّان في الطور الأخير من حياته. وإذا كان غرامشي رأى في المثقف الريفي الأصول صفات مثل الاستعلاء ومغازلة السلطة، فقد نأى د. إحسان عن الصفتين، آثر العزلة والاعتكاف، وسخر من الألقاب”.
يبقى في كتاب درّاج هذا الكثير مما يستحق التناول، وخصوصا في تنظيراته وتفكيكه للمفاهيم، وعلاقته بالسينما (دور السينما والأفلام العربية والعالمية)، لكنني سأشير أخيرا إلى استدعاء درّاج لبيت من الشعر يعتقد أنه لشاعر الأندلس ابن زيدون، وهو يكرر ذلك مرتين، تعبيرا عن شعوره بتحولات الزمن وتقلباته، والبيت هو: هِي الأمـورُ كما شاهَدتُها دولٌ/ مَـن سرّهُ زمن سـاءتهُ أزمانُ، بينما هذا البيت- في اعتقادي- هو للشاعر الأندلسيّ أبو البقاء الرندي...!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“ضفة ثالثة” – 2 تشرين الأول 2024