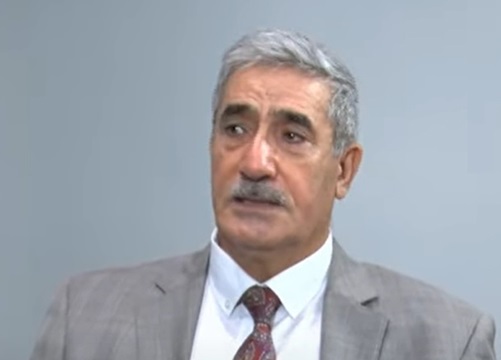كلما رأيتُ فلاحا مكدودا، تذكرتُ وجه أبي، شمران الياسري، الفلاح الذي زرع كل شيء. وكلما رأيت حقول الحنطة، تذكرت الفلاحين الذين كتب عنهم شمران ودافع عنهم لآخر لحظات حياته. وكلما رأيت السنابل ناضجة في مواسم الحصاد، تذكرته، حينما أدان الإقطاع وآدان قسمته الظالمة.
في كل ما كتب شمران، كان إحساسه بالناس لا يحيد عما يشغلهم، هو صاحب المجسات التي تعرف ما يوجعهم ومواضع أوجاعهم. فهو لم يكن متفرجا، بل شريكا، وأحيانا دليلا لهم.
فكل الأوجاع كانت تتمثل له مثلما تؤلم أهلها. وكانت أكبر أوجاع العراقيين في الأرياف، وفي قلوب الفلاحين.
أوجاعٌ أصلها الفقر ثم الجوع فالأمية فالجهل.. وبعد ذلك تنهض الفطرة السليمة النقية التي تعوض عن الفقر بالقناعة والشرف، ويعوض الإيمان والثورة بداخل الناس عن فرص التعليم.
كان شمران دليل الفقراء والمحرومين من الخبز والحقوق.
شمران تجربة إبداعية من تجارب مثقفي العراق، رغم كل إبداعات الكتاب والشعراء والروائيين والصحفيين. فتجربته الغنية في خصوصيتها لم يتجرأ أحد على الخوض فيها بسبب السد العالي الذي بناه شمران، دون أن يقصد، لخوض الآخرين تلك التجربة. فلم يمتلك أي من مثقفي العراق هذه القدرة العجيبة في الحديث بلغة الريف العراقي ثم بلغة المدينة ثم باللغة العربية الفصحى، اللغة الأنيقة التي كانت كل مفرداتها تظهر في مطبخ لغوي وفكري ثقافي وروحي متميز.
كانت تجربة شمران الياسري في الكتابة قد بدأت في وقت مبكر جدا ربما حين كان عمره حوالي 20 عاما، فكما يقول هو، بدأ وهو في الريف بكتابة المقالات وإرسالها إلى صحف بغداد ومجلاتها، وكانت تنشر ربما دون أن يعلم متى نشرت، ثم تصل له الأخبار أو تصله الجريدة أو المجلة. وعندما اصبح شيوعياً، صارت الكتابة مطواعة لقضية محددة، مع أن كتاباته السابقة كانت تتحدث عن هموم الناس ولكن مركبها لم يكن قد سلك النهر العظيم الذي هو فكر رفاقه الشيوعيين.
وحين قامت ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة عام 1958 كان هو من الرعيل الأول الذي اشتغل في برامجها التوعوية والثقافية والتبشير بمبادئ الثورة وبخطوات الإصلاح الزراعي. وكان برنامجه الإذاعي وكتاباته في الصحافة هي زمن الثورة قبل اغتيالها في الثامن من شباط 1963 إحدى العلامات الفارقة في الإعلام العراقي.
فحين جرى اغتيال الجمهورية الأولى في ذلك اليوم الأسود من شباط، كان شمران في خضم الحدث المأساوي الكبير في العراق، ولكنه استطاع أن يرحل إلى الجنوب في محافظة واسط ليبدأ مع من تبقى من المطحنة البشرية التي فعلها البعثيون في آلاف الشيوعيين والوطنيين العراقيين، مسيرته في ريف العراق مع رفاقه.
ومع أن العمل النضالي الذي كان منخرطا فيه كان شديد الحساسية والخطورة، إلا أنه لم ينس وظيفته التنويرية حينذاك وباشر بإصدار نشرة او جريدة بخط اليد لإيصال أخبار الحزب والقوى الوطنية إلى الجماهير، ثم زوده الحزب بجهاز طباعة والذي يسمى الرونيو، مما سهل عليه إصدار أعداد أكثر وأوسع وأصبحت جريدته (جريدة الحزب) تصل إلى بقية محافظات العراق وإلى الذين انقطعت بهم السبل خارج العراق. ثم استكمل رسالته بإعداد حديث إذاعي تسجل منه عدة حلقات ويرسل إلى إذاعة “صوت الشعب العراقي” التي كانت تبث من براغ عاصمة جمهورية جيكوسلوفاكيا والتي حملت أخبار العراق ونشاطات قواه الوطنية. ومع كل هذا الزخم والجهد الإعلامي والتثقيفي الكبير، فإنه كان يحلم أن يكون روائيا على حد قوله، فبدأ بكتابه روايته (الزناد) بأجزاءها الأربعة خلال المدة من سنة 1964 ولغاية 1972 حيث صدرت في بغداد. وكنا نتابع جهوده في كتابة هذه الرواية أولا بأول، إذ كانت الكراريس والدفاتر التي يدون فيها روايته تعرض على رفاقه حين يأتون، ومنهم رفاق مثقفون وضباط سابقون وصحفيون.
ولتلخيص فرادة شمران الياسري/ أبو گاطع، بعد التجرد من العلاقة العاطفية معه، فإن أسلوبه في كتابة المقال اليومي ومعالجة قضايا الناس في ظروف كانت فيها الكلمة تساوي أحيانا (حز اللوزتين)، فإن سخرية أبوگاطع من النظام ومن البيروقراطية ومن الفساد لم تكن سخرية عادية بل كانت في قمة الجرأة وربما المغامرة في زمن بدأ فيه النظام يستقوي على الكل بما فيهم رفاقه. فكان الناس يتابعون مقالته اليومية وهم مدركون أنها نبض الشارع ومجس الحراك السياسي والشعبي، كما كان برنامجه اليومي (احچيها بصراحة يبوگاطع) الذي قدمه بعد عام 1968 لمدة أربعة أشهر قد احتل الصدارة في عديد من يستمع إلى إذاعة بغداد من أجله، حتى ضاق ذرعا به النظام ومسؤولوه وإعلاميوه فبدأت الضغوطات تكثر عليه إلى ان تم منع البرنامج.
وتبقى رواية “الزناد” الرباعية بأجزائها الأربعة ثم رواية “قضية حمزة الخلف” واحدة من أهم الأعمال الروائية التي غطت فترة زمنية تجاوزت أربعة عقود من تاريخ العراق الحديث، ابتداء من انتهاء ثورة العشرين وما فعله المستعمر بالعراق، حين خلق طبقة الاقطاع والأذناب، وغيّر بشكل متعمد علاقات الإنتاج التي كانت علاقات أبسط بكثير مما أوجده المستعمر، ثم الانتفاظات والثورات التي مرت بالعراق وصولا إلى ثورة الرابع عشر من تموز 1958 وما بعدها.
لقد حكى شمران القصة العراقية الغريبة من خلال روايته “قضية حمزة الخلف” التي تناولت مصير العراق والعراقيين بعد شباط الأسود.
في هذه الليلة التي نستذكر فيها رحيل مبدع كبير وروائي وصحفي وإنسان، نقول أن بقايا النذور التي بدأها شمران الياسري لم تزل موجودة ولم يزل الجمر تحت الرماد في العراقيين ومثقفيهم والوطنيين منهم، ممن يرون في العراق تلك البقعة التي باركها الله تعالى على كوكبنا، ولم يزل الأمل معقودا بالعراقيين لتغيير حياتهم نحو الأفضل.