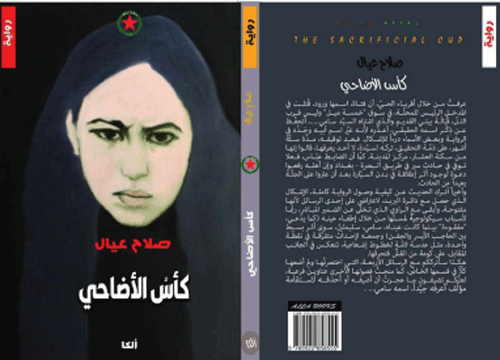يُعد الروائي وسائر المشتغلين في الحقل الإبداعي/الثقافي ضمن مجال يُراد له أن يكون مظلماً، أو مقصياً، من قبل المنظومات الحاكمة للمجتمع [ منظومة القوانين، تشريعات دينية، أعراف وتقاليد قبلية.. إلخ] لكنه، بنتاجه الإبداعي، نجده يشاكس ويعمل على تحريض العقل ضد كل ما هو مترسب من عادات وتقاليد تشي بالتخلف وإظهار الاعتلالات الاجتماعية على السطح. وهذا اللون من النشاط الأدبي أحسبه محايداً في طبيعته، لكنه يتأرجح في وقوفه ضمن حدود فاصلة بين المجتمع وحزمته الثقافية من جهة وبين السلطة ودورها من جهة أخرى، فتارة نجد الأديب يحفر بين طبقات الزمن بحثاً عن أسباب ترسيخ الموروثات الاجتماعية الصدئة، بغية تقييمها أو تقويمها أو إزاحتها، وتارة أخرى نجده يقف بالضد من كل حركة مجتمعية تسير إلى الوراء، محاولاً، بإبداعه، إيقافها أو تعديل وجهة سيرها في أقل تقدير. وفي جميع نشاطات الإبداع الأدبي والفني والثقافي يبحث المبدع عن الأبواب الموصدة في منظومة الوعي المجتمعي غير الحر، يقف محاولاً فتح أحدها، أو كلها. فربما يُفتح نصٌ شعري باباً للتأمل، أو قد تلفت مقالة ما نظر شريحة من المجتمع فتقود الرأي العام نحو تحقيق مطلبٍ مهم، أو قد يغذي عملاً دراميا عطش الخيال لدى عامة الناس فيرتقي بالذوق والحس الحياتي بشتى مفاصله. وهنا السلام أحسب أن رواية كأس الأضاحي للروائي صلاح عيّال، التي صدرت مؤخرا عن دار ألكا، أحسبها واحدة من الروايات التي تستحق الاهتمام والقراءة، إذ من شأنها أن تسلط الضوء على أغلال كثيرة نستعملها بتوارث مع أنفسنا، كتلك التي قيدت المرأة بسبب سطوة المجتمع الذكوري وكذلك من شأنها أن تكشف عن طبيعة الحكم في العراق وأنماطه بعد 2003.
فما إن تبدأ بقراءة رواية كأس الأضاحي، حتى تجد نفسك مُنشدّاً لتكملتها، فهي رواية تميزت بتشابك الأحداث وإثارة الجدل بشأن قضايا مجتمعية مهمة، قضايا لا تخص المرأة حسب، إنما تجس مناطق حساسة في البنية الثقافية للمجتمع، كمرورها بجوهر السياسة والفقه الديني والعادات القبلية وغيرها. فضلا عن رسالتها السامية، إنها تطوف بقارئها حول أحداث عديدة مشوقة تلامس أوجاعا كثيرة من افراد مجتمعنا، فكثير منا يحتفظ في خزانة ذاكرته بحكايات عن قتل العار، أو ما تخلفه الرشوة وعلاقتها بالمشكلات الاجتماعية، أو، طرائق التعذيب والاستجواب في مراكز الاعتقال والشرطة، في هذا العهد وما قبله.
تتحدث الرواية عن شخص مفقوء العين اسمه سامي، يعثر على جثة جارته مقتولة قرب سكة القطار في منطقة خمسميل ذات الطابع الشعبي، شابة تُدعى ورود. وتبدأ الأحداث تأخذ مسارا هادئا ثم تتشعب بطريقة تصاعدية دون ان تفقد الرواية وحدة موضوعها، فنجدها تفرض على قارئها المضي في تقليب صفحاتها لبلوغ النهاية. وأثناء التجول الأدبي بين صفحاتها نعثر على جدلٍ مهم، تكمن أهميته بما يتعلق بعمر الزواج وأساليب التحقيق القضائي وزواج القتيلة من شيخ يدعى سعد الدين، حيث تزوج منها بسن مبكرة بطريقة تعكس عقد الشذوذ عند كثير ممن يتوارون خلف الدين وعلاقة الأخير بالأحزاب والحصانة التي يتمتع بها على الرغم من دنو مستواه الديني، فهو، كسواه من الأئمة الذين تكاثروا بعد 2003،لغف.
في ظني، نجح صلاح عيّال بتعميد روايته بجرأة الأسئلة عن القضايا المسكوت عنها، نجح في استعمال البصيرة بدلاً من البصر بالعين المفقوءة، كما جاء في الحوار الذي دار بين ضابط التحقيق وسامي، نجح أيضا في صناعة جدل مهم يتعلق بالموت وما بعده، كغسل الميت وما رافقه من ومضات تساؤلية، كضرورة الكف عن الحديث عن الميت، حيث توارى عن الحياة إلى الأبد، تطرقت الرواية للسكن العشوائي الذي اتسعت رقعته بعد 2003 كما إن البناء السردي الذي استعمله عيّال في روايته سهل وغير متكلف، الأمر الذي جعل من روايته جاذبة وشيقة، إذ إن من مهمات الرواية الناجحة أن تقدم للقارئ المتعة والإفادة والتوثيق لقادم الأجيال. وأية رواية تؤدي المهمة على هذا النحو فقد أدت واجبها بشكل سليم. لاسيما إن رواية كأس الأضاحي قريبة من الواقع وتفاصيلها تكشف عن المقيدات المجتمعية، بدءاً من المخلفات السياسية والموروثات القبلية وليس انتهاءً بنوبات التفاهة التي نتعرض لها بين الحين والآخر. أحسب أن هذا اللون من السرد هو أحد أنواع الصفعات المنبهة اجتماعيا فيما لو اعتبرنا أننا نعيش في حالة من الغيبوبة إزاء كثير من منغصاتنا. أرى أن صلاح عيّال اعتمد الصدق في كتابة روايته، وأعني بالصدق هنا أنه كتبها وهو على دراية بالمكان والزمان، إذ من المفضل أن يكتب الروائي في أشياء ملم بها، صحيح إن المخيلة لها دور في صناعة العمل الأدبي المشوق لكن الصحيح أيضا حين تكتب عن البحر لا بد لك أن تكون قد شاهدته ذات مرة.