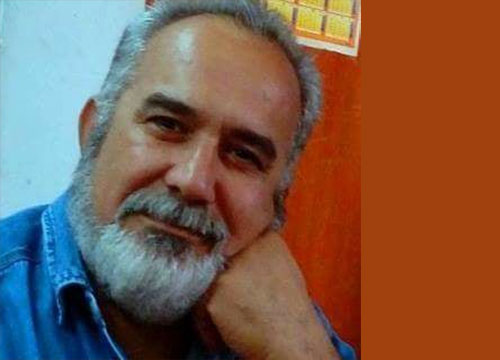لستُ بصدد إشغال المشرط النقدي للبحث عن ثغرة ما ، طالما أننا ننظر إلى النقد بوصفه بوابة بمداخل متعددة. فالكاتب سيتأكد من جغرافيا ابداعه، والقارئ سيجد فيه مرشدًا يفكك مغاليق السرد التي تعترض طريقه في تأويل النص. الأمر لا يتعلق بتحديد معالم النص ممثلة بالشكل والمعنى، طالما صانع النص أحكم تأسيس ذلك بقدرته الفذة التي كشفت عن احتراف وتمكن من أدوات القص كحكاية ولغة ومعنى. لست بصدد وضع النص القصصي على طاولة تشريح نقدي وفقًا للأسطورة اليونانية التي قدمت لنا سريرًا يفترض خضوعًا مطلقًا لإملاءاته؛ فالطويل ستقطع ساقاه، أما القصير فسيُضطر إلى مَطِّه لكي يتوافق مع رغبة بروكروستس واشتراطات سريره التي لا تتغير. إذا اعتبرنا أن النقد يُخضِع النص لشروطه التي تتطلب امتثالًا تامًا لها، فلن أخوض في التعريفات أو الهوامش التي يتبناها النقد، ليس لأن (السجين عبد الصمد) لا يستحق العناء، بل في حقيقة الأمر أرى أنه جدير بأن نستعين بأدواتنا المعرفية للعمل على حفريات تغور عميقًا في متن خصب لكي ننتهي بإضاءة ساطعة تكشف عن تناسق الشكل والمعنى. أكاد أتلمس طريقي في عتمة الزنزانة حيث تمددت بقايا هياكل بشرية تنتظر الموت. فالسارد، وهو العليم، لم يكن سوى راوٍ محايد يسرد لنا الأحداث دونما أن يُظهر موقفًا محددًا مما يحدث، بل إنه ترك لنا ذلك الخيار: أن نحدد موقفنا ونحن نسترسل في قراءة ما يحدث في تلك الزنزانة القصية. رغم أن الجانب الأخلاقي يُملي علينا أن نفعل ذلك: أن نتخذ موقفًا. لكني لا أعرّج على المحور الذي قد يندرج تحت مفهوم "العقائدية"، فالتعاطف سيفسر على أنه انحياز،. ولكن الأمر مع قصة السجين عبد الصمد كان أكثر عمقًا وتأثيرًا من تأطيرها بهذا المفهوم. لم يكن القاص يعمد في الظاهر المُعلن إلى إقحامنا في متنه، بل إنه يكبِّلنا في معتقله ويضعنا لنتقاسم معاناة سجناء يتناوبون على تلقي ألم التعذيب البربري الذي يمارسه سجانون مرضى بعُقد نفسية. سجناء مُذلّون مُهانون يتلذذ سجانو المعتقل بتعذيبهم بـ "طناجر" المَبولة. أتقن القاص لعبته الإبداعية فهو لم يخبرنا بانتماء السجناء السياسي أو الفكري، بل أغفله عن عمد وسبق إصرار يكشف عن ذكاء ينتظر من القارئ أن يبني تصوراته بنفسه. فقد ترك له اكتشاف هذه الأحجية، إلا أننا ندرك بأنهم وطنيون أحرار يترنمون بنشيدهم الوطني رغم الموت. النشيد هو الآخر غامض، فهو بالتأكيد ليس نشيد السلطة التي تزاول القمع الدموي وتصفية خصومها، إنه نشيد أولئك السجناء، الذي انبثق من عتمة الزنزانات المعتمة الرطبة بزنختها الخانقة. ليس هذا فحسب، إننا أسرى المكان الذي صنعه طه الزرباطي حين أقحمَنا في مكان معتم ملطخ بالدم والقيح، حيث يتبول السجين في طنجرته التي تتحول إلى أداة للتواصل، فيرسل السجناء رسائلهم بالنقر عليها كما لو كانت شيفرة "مورس" يتبادلون ما يحدث في الزنزانات الأخرى. إنه يُبقينا في متنه بعد أن أقحمنا في زنزانته الضيقة. ما يجري في جوف تلك الزنزانة يبدو خارج الزمن، فالحدث يسيل ببطء، ولكننا نصر على الانغمار في القراءة علّنا نطمئن أنفسنا بأننا على وشك المغادرة بأقل الخسائر، أن يُطلق سراحنا لسبب ما! لم يحدث ذلك، كنتُ عالقًا معهم أنتظر متى يحين دوري لأتلقى حفلة التعذيب الجماعي الذي يمارسه السجانون دفعة واحدة. المكان خانق، زنخ، الجميع ينتظر الموت أكثر من أي شيء آخر، بينما الزمن كسيح يزحف ببطء تحت إيقاع التعذيب الجسدي، حيث يتمدد السجين عبد الصمد الذي يشعر بأنه تلقى إذلالًا أكثر إيلامًا من سجانيه حين نظر إليه رفيقه نزيل الزنزانة بارتياب متهمًا إياه بأنه تخاذل أمام جلاده فاعترف! تلك الذروة الهائلة التي كشفت عن معاناة من نوع آخر، فالسجين عبد الصمد تلقى بصدر رحب تعذيب جلاده، ولكنه لم يُطق نظرة رفيقه التي تشكك في صموده. نحن ندرك ونعيش عذابات المشهد ولكن عن بُعد، وهو الأمر الذي يتيح لنا إصدار حكم أخلاقي يبرئ أولئك السجناء من تهمة الوشاية، فالجسد البشري لا يتمتع بالقدرات الاستثنائية التي تستطيع أن تمنع عنه الإحساس المريع بالألم. القاص كان المرشد الخفي الذي جعلنا نخوض المتن بدهشة الثيمة والعمل المحكم، حيث ينتهي السجين عبد الصمد بالموت ليتحرر من سجانيه، بل والأكثر، ليتحرر من نظرات عينَي رفيقه، تلك النظرات التي تتهمه بالوشاية. تنتهي القصة بنهاية مُحكمة، حيث يغادر جواد عبد الحق، رفيق الزنزانة، السجن بعد الأحداث التي طالت العراق. يقول الكاتب في متنه: (يجد نفسه يتجه كل مساء إلى مبنى السجن المركزي الذي هدمته طائرات الاحتلال الأمريكي! يصنع لنفسه مقعدًا من بقايا الآجر تغزوه الذكريات، هنا سقط (صمد) وهنا بكى لأول مرة في العلن...).قصة جديرة بالثناء، وقاص يدرك كيف يقحمُنا في قصته ويبقينا معه حتى آخر كلمة فيها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*نشرت في الصفحة الثقافية لجريدة "طريق الشعب" العدد/142الاحد 27تموز2025