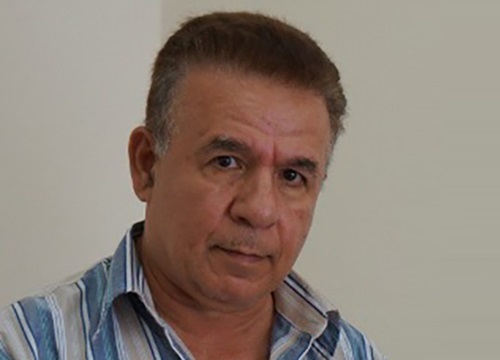إنّ الوحدة المتميّزة للبنية النصّية، تنصهر مع الثقل الشعري، ولا يأتي الثقل الشعري إلا من خلال اللغة الخالصة التي توفر لنا العذوبة الجماليّة؛ ولكن في الوقت نفسه هناك المتعلّقات الذاتية التي توفّر المعنى القصدي، ويتداخل موضوع المعنى مع موضوعات مصغرة، ولا تعد هذه الخصوصية مقاطعات الذات، بقدر ما تكون الجزء الأوفر لعملية البناء النصّي.
إنّ البنية الدالة الرئيسيّة في النصّ تكمن في ظواهر وأشكال لغويّة، قد يرمز إليها الشاعر، أو يوظف بعض الإشارات التي تقودنا عن قرب إلى ذلك النسق الممتدّ والذي يؤدّي إلى الدالة الرئيسية. وبحكم العنونة التوضيحية وما قدّمه الشاعر ليث الصندوق (نحن نصنع الطغاة)، فقد ارتبط العنوان مع الجسد النصّي، عبر ظواهر ومفاهيم تكيّفت مع الموضوع القصدي الرئيسي. "أيها الطاغية/ عندما انزاح الستار/ ورأيناك لأول مرّة / تسكب من الزجاجة ابتسامتك المائعة/ لم تكن يومئذ أصابعك قد ضُفرتْ حبالاً / ولم تتحوّل مساماتُكَ مزاغل للقنّاصة / كنتَ وديعاً كطفل وِلِدَ من قلب نبتة الخس / عندما كنا ننظر لأصابعِك التي تموع من التوهج / نظنّ أن الشموعَ صالحة للأكل".
يشتغل دال المعنى على المتعلقات الذاتية المطروحة، والذي نلاحظه أنّ الشاعر وظف الخاصية الإشاريّة لظهور تلك المعاني، فبعض الكلمات تحتفظ بالمعنى داخل بنيتها؛ مثلا: الطاغية، الابتسامة والشموع، وفي الوقت نفسه تكون الحالات التركيبيّة قد أوّلت الكثير من الجمل النصّية، ومن خلال الاختلاف اللغوي والتقليل الزمني بين الجمل، أعطت أموراً إدراكيّة ملحّة. لقد جعل الباث الحقيقة ملتصقة بالفرد بذاته، وهو الطاغية الذي دمجه من خلال الخطاب (أيّها الطاغية)، وتمّ جمع الفرد مع الأشياء المحيطة به، وكذلك بعض الوسائل التي يستخدمها الطاغية. إذن، تكون الإرادة مندمجة مع الأشياء، وهما إرادة (الطاغية) والأشياء تكون وسائل توظيفيّة في المنظور النصّي. (يقول التجريبيّون الإنكليز: إنّ مادة الإدراك الحسّي هي أفكارنا عن الأشياء، أمّا الأشياء بذاتها فنحن لا نعرفها لأنّ الذات تقف بيننا وبين حقيقة هذه الأشياء. وإنّ كلّ مايصلنا من هذه الأشياء، هو صفاتها الحسّية، فنحن ندرك الأشياء عن طريق المعطيات الحسّية. – د. رشيد الحاج صالح – المنطق واللغة والمعنى في فلسفة فتجنشتين - ص 183). "كانت نوايانا طيّبة / لكنّنا بغبائنا الموروث / أعطينا مفاتيح قلوبنا لغير المؤتَمنين / فصاروا يؤجرونها شققاً للقتلة واللصوص / وها نحن اليوم ندفع ثمن أخطائنا".
إنّ الشاعر يقف مع القول والقول المتقدّم، فالمعنى يكمن ويظهر من خلال القول، وعندما نفتّش عن بنية المعنى القصدي، نلاحظ أنّ القول الآني هو المعنى، لذلك يقف الفكر (التفكّر أيضاً) مع اللغة المنظورة التي تتواصل بصيغة أفعال كلاميّة غير مباشرة. مثلاً:
كانت نوايانا طيبة / لكننا بغبائنا الموروث / أعطينا مفاتيح قلوبنا لغير المؤتَمنين".
فاللغة هنا هي المؤسّسة للفعل الكلامي. نلاحظ أنّ البنية النصّية تارة تكون محالة إلى الذات، وفي هذه الحالة تُظهر حقيقة الذات ومتعلقاتها، وهي تخلق بشكل آلي صورها الشعريّة بمساهمة الوعي؛ وتارة أخرى من خلال فعل الإشارة، وذلك لكي تظهر في المنظور الكتابي دلالتان، الدلالة السياقيّة والتي تتبنّى الفعل السياقي من خلال العلاقة الاجتماعيّة والفكريّة والوظيفيّة.
"لقد دللناك كثيراً أيّها الطاغية / اِستبدلنا مفاصلك بالبراغي / وشرايينك بأسلاك الضغط العالي / كان أملنا أن نحوّلك إلى مولدة طاقة / لنضيء المستقبل بإيقاعات خطواتك المتوهّجة / لكنّنا أخطأنا / بإعطائك جرعات مضاعفة من الأناشيد والهتافات / فتصلّبتْ في أعماقك / متحوّلة لأكوام من الشتائم تتقبّل دلالة الإشارة توضيح المعاني، وتتقبّل أيضاً المعنى المدغوم في النصّ، وللتواصل مع المعنيين هناك الاستدلال المتعلق بالإشارة، فيكون التأمل النصّي خاصية خارجيّة، أي أنّ الرسالة بمفهومها، تكون في ذهنية المتلقي، وتسعفنا علاقة دلالة الإشارة باللفظ كونها تظهر مدلوله؛ ومن هنا يكون لحركة الأفعال وظهورها، خصوصيات دلاليّة بمفاهيم قصديّة؛ مثلا الفعل (دلّل) في الجملة الأولى، يعتبر من الأفعال التموضعية، وحركته تكمن في المعنى، ونقيس معظم الأفعال وحركتها من خلال؛ الحركة والانتقال والتموضع، وبعض الأفعال خصوصيتها تكمن في المعنى السياقي للجملة. من الممكن أن تكون الإشارة خاضعة لبعض الرموز، كما أشار اليها الشاعر ليث الصندوق في بعض المفردات، ومنها؛ (البراغي، الأسلاك، مولدة الطاقة، الأناشيد، الهتافات.. إلخ). ومن الطبيعي لكلّ رمز تركيبه اللغوي، وفي هذه الحالة تتعدّد المعاني والقراءات. "نحن صنعناك أيّها الطاغية / وسمحنا لخرافك المسلّحة / أن ترعى بمفارق شعرنا / ثمّ رحنا نجأر بالشكوى / من لزوجتك التي حرمتنا من الحركة / تُرى كيف غفلنا عن الدُمّلة / حتى تضخّمت وابتلعتنا / نعم، نحن صنعناك / ونفخناكَ / حتى صارت رئتاك / تمتصّان كلّ ما في مستقبلنا من الإبتسامات".
يقودنا الشاعر ليث الصندوق إلى الاستعارة التي توالت في الاختلاف اللغوي، ومنها اشتق مبدأ التشبيه أيضاً، فالبنية الاستعارية لا تشكّل السياق قاطبة، بل إنّ الإطار اللغوي يعتبر سياجاً فعّالا للنصّ، لذلك فقد قال أرسطو: (إنّ التشبيهات عبارة عن استعارات تتطلب شيئاً من التفسير والتوضيح – د. يوسف أبو العدوس، - كتاب: الاستعارة في النقد الأدبي الحديث – ص 51).
تُرى كيف غفلنا عن الدُمّلة + حتى تضخّمت وابتلعتنا = لقد شبّه الطاغية بالدمّلة، وهذا يعني أنّه أنزل الطاغية إلى هاوية القبح. ومن خلال هذه العبارات؛ أستطاع الشاعر أن يبيّن لنا الدلالة الثانية، وهي الدلالة المركزيّة في الجزء النصّي المكتمل، ذات علاقة مع البنية القوليّة، حيث أنّ القول يتحوّل إلى كتابة، لذلك فالمنقول هو: النصّ المقروء، الذي تحوّل إلى نصّ مكتوب؛ والمقروء هو ما تحتويه الذات الحقيقيّة من متعلّقات ومفاهيم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة: نُشر النصّ في جريدة طريق الشعب العدد: 92، الصادر يوم 16 آذار لسنة 2025