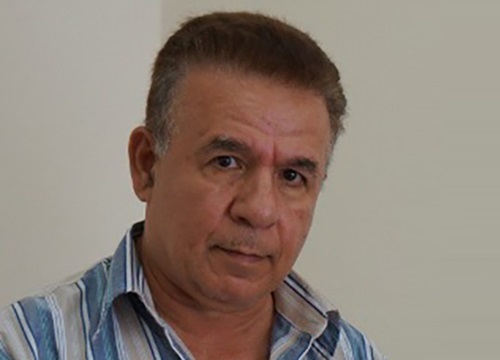عندما يكون القول قد قال شيئاً، فالشيء الذي نقصده إمّا من الأشياء المرئية، أو الأشياء اللامرئية، فالأوّل تفسير تكييفي وجدلي للأشياء التي تعوم حول الذات الحقيقيّة، وعندما ندخل الترتيب القولي، فسيكون القول من إنشاء القائل، أمّا إذا بقي مطلقاً خارج الأشياء، وحتى الأشياء اللامرئية، فتكون الحالة القوليّة محبوسة في القلب، لذلك نقول القول الداخلي (القول الذاتي الذي لم يخرج إلى التجانس القولي).
إنّ ما يريده القول، هو تبنّي الإخبار الكتابي، وهذا يدعو على اندماجيات وعلاقات قوليّة، لكي يترجم الباث القول المناسب من خلال النسق الناضج لكلّ قول قد تمّ تحويله إلى الكتابة، وحتى تلك الإيحاءات التي لا تقول شيئاُ، ولكنّها تشترك في عمليات الاستدلال والحوار، لكي لا يُترك المخاطَب بفراغ من القراءة، ونعني هنا تكوين البنية الحركيّة للقول الكتابي؛ وكلّ حركة قوليّة تصحبها بنية لغويّة عليا، وهي الوحدة الخطية التي تدخل في نظام الكتابة.
سنكون مع بعض المشتركات القولية في الوحدات الخطية التي تساهم في الارتباطات والعلاقات بين قولٍ وآخر، وهي الجهات التعبيرية للوحدات اللغويّة والدلاليّة.
ما بعد القول: إنّ التحوّلات التي تلازم النصّ، تبدأ بالخروج من القول إلى القول الكتابي، وأي استقرار كتابي يُعتبر من المفاهيم الموضوعيّة، حيث أنّه لا يمكن توظيف القول دون معاني تلازمه، وحتى بعض التأويلات التي تتطابق مع الكتابة من جهةٍ، ومع الأنساق النصّية من جهةٍ ثانية، كما أنّ بداية الكتابة، هي البداية القوليّة التي تصبح وحدة لغوية أولى. ولكي نكون مع القول المشترك، بين الحوار والتعبير الذاتي، فهناك ثلاثة مستويات قوليّة ينتجها القول، وهي: المستوى التعبيري المعرفي، بشرط أن يرافقه الفعل التأثيري، وخصوصاً بحالات الحوارين الداخلي والخارجي (في كتابة الرواية)، وما يتوفّر للباث من نقل، ومعارف، ومعتقدات، ومسميّات، وكذلك بعض المتعلقات الذاتية، تنعكس هذه المناطق على القول الكتابي، والمستوى الأخير، هو المستوى الضمني، وهو الأثر الاستدلالي وتوصيله بصيغة مفهومة للمتلقي؛ وذلك لأنّ الشخصيات بحالات متغيّرة، وتكون حسب النمو الزمني.
إحالة القول المقروء: تعتبر الإحالة القولية هي نقل شيء إلى آخر، أي أنّ القول المقروء يتحوّل إلى القول المكتوب، وهو القول الذهني قبل الكتابة، وتشير الإحالة إلى تلك الدلالات وآثارها التواصليّة، فيكون السابق ملحقاً باللاحق، ومن هنا، تكون إحالة الأشياء إلى ألفاظ قولية أيضاً، وذلك من خلال الفعل الكتابي، فالعملية التي تواجهنا، هي إيجاد سياقات قوليّة جديدة وذلك عندما يكون القول قد رُتّب للكتابة، ونحصل على فعلٍ كتابيّ سرديّ، فالتعبيرات التواصلية تكشف عن وظيفتها النصّية داخل النصّ.
الدلالة القولية: تتعلق الدلالة القوليّة بالحسّية الداخليّة، ومن هنا تبدأ العلاقات الدلاليّة بين اللغة النصّية والمعاني الدلاليّة، لذلك تشترك القوى النفسيّة بتلك الوظائف " 1 "، (والقول بقوى نفسيّة مختلفة يصدر عن كلّ منها فعل خاص قد يوهم بانفصال الوظائف النفسيّة بعضها عن بعض، وقد يؤدّي بنا إلى تقسيم الحياة النفسيّة إلى أقسام مختلفة متمايزة ومستقلّ بعضها عن بعض. وقد يفهم ذلك أيضاً من بعض عبارات ابن سينا مثل قوله: "إنّ كلّ قوّة لها فعل أوّلي ولا تشارك قوّة أخرى لها فعل أوّلي مخالف لفعلها الأوّل " 2 "). وإنّ ما يحمله الباث من فكر يساعد على تغذية اللغة وتوظيفها في النصّ المكتوب.
اندماج القول الكتابي: يبدأ الاندماج القوليّ من المجهول إلى المعلوم، ومن المرئي إلى اللامرئي، حيث أنّ الأشياء المنظورة، والعبارات المعلومة ومنها المباشرة، يتمّ تحويلهما بواسطة القول الكتابي إلى علاقاتٍ كتابيّة، فيكون الاختلاف الجمالي في منافسةٍ حرّةٍ حول البطل الجماليّ، والذي يكون الخاصّية العليا في الرواية الحديثة.
الكتابة القولية
بداية أن يكون القول مقروءاً في الذهنية ومن ثمّ مكتوباً، وكلّ قول يُترجم إلى الكتابة، يعني أنّه في إطار القراءة؛ لذلك يستعين الباث من خلال الكتابة القوليّة بمقاصد من المعاني لكي تتوسّع دائرة الكتابة، وتتوسّع الدائرة القوليّة، لأنّ الباث ليس له التوقيت المبرمج من ناحية الكتابة، لذلك فهو ينطلق من اللغة الصامتة التي تستعمر الذات إلى اللغة المنطوقة التي تنفتح على الآخرين بصوتٍ مسموع؛ ومن هنا يكون لفلسفة الصمت إعلان النطق، ولفلسفة النطق تصحيح الكتابة المرتبطة بعلاقاتٍ لغويّة وذهنيّة.
إنّ العلاقات الوقائعيّة تحدّد ديمومة العمل وتتبنّى مصداقية الحدث المنقول، فتعتبر الكتابة ذات أهمّية قصوى عندما تكون في دور البناء، وهي تتكئ بكلّ تأكيد على معاني مختلفة تساهم في بناء النصّ بلغةٍ تحمل صورتها وتأويلاتها.
عندما تكون المعاني نوعاً من أنواع القصدية، فالقول يرافق المعنى، إذن، إذا فكّكنا الموضوع من الناحية الاستدلاليّة، فالقول (استدلاليّاً) أحد أجزاء القصديّة أيضاً، وليس هناك قول خارج القصد إلا في حالة الهذيان، فيكون الوهم حاضراً، ومن خلال هذه السلسلة الاستدلالية نلاحظ أنّ القصدية جزءاً من الاستدلال، وأنّ المعنى يتقبّل الاستدلال، إذن في حالة جمعهما في زمنيّة واحدة، فسوف يكون هناك اختراق للاستدلال من خلال الزمنيّة والتي تفيدنا في ظهور الأماكن المرافقة لها فيستدلّ الباث حتى إذا كانت تلك الأماكن حاضرة من خلال الإيحاء.
فعل القول الوظيفي
يبدأ فعل القول كوظيفة ذاتية أوّلاً بتحريك اللغة، ويعمل على تحريضها في النصّ المكتوب، كفعلٍ قوليّ استعماليّ له الشأن بالتدخل بوظائف النصّ والعمل على تأويل المعاني من جهةٍ، والاعتناء بالاختلاف اللغوي من جهةٍ ثانية، حيث أنّ الشعرية تكمن في التقويم النصّي عندما يكون الشاعر عنصراً من عناصر النصّ وذا علاقات نصّية، وكما أنّ هناك فعل القول الذاتي المتقدّم، وفعل القول الذاتي المتأخّر، والاثنان يعملان على التحريض وإثارة المعنى وتدجينه كموضوع قولي يخرج من الممارسة اليوميّة إلى الممارسة اللغويّة. تعتبر المدرسة البنيويّة الإطار العام للكثير من المدارس ومنها المدرسة الوظيفيّة، ولكن، وفي الوقت نفسه، فإنّ البناء الفعلي للنصّ والنصّ المتقدّم يتكئ على بنى لغويّة حركيّة، وهي القاعدة التي تغذينا وكأنّنا نعيش مع اللابديل، وأيّة بدائل نبحث عنها طالما أنّ العمل يكون مع الجملة الوظيفيّة وتركيباتها في المنظور النصّي؛ هذه التشخيصات التي تقودنا إلى علاقات منهجيّة بين الوظيفة الأدبيّة كمحرّك فعّال في المنظور النصّي، والجملة أو العبارة، التي تبني العلاقات التواصليّة كنصوصٍ تواصليّة ومصغّرة داخل المتن ومدى إثارة التأثيرات الداخليّة لتصديرها خارج النصّ. (استجابة للمبدأ المنهجي العام المعتمد في اللسانيات الوظيفية والقاضي بأنّ بنية العبارات اللغويّة التي تعكس إلى حدّ بعيد وظيفتها التواصليّة، يُمثّـل، في النحو الوظيفي، لبنية الحدود في شكل سلسلة من المقيّدات تقوم بدور الحصر التدريجيّ للمجموعة المحال عليها. بواسطة عملية الحصر هذه، يتمّ تعيين المحال عليه، أي جعل المخاطب يتعرّف بطريقة تدريجيّة على الذات التي يقصد المتكلّم الإحالة عليها. " 3 ").
عندما نطرق أبواب الوظائف اللغويّة والتي تقودنا إلى أفعال إحاليّة من جهةٍ، وإلى تماسكات نصّية من جهةٍ أخرى، فنحن في مناطق نصّية تقودنا إلى سياقات متعدّدة؛ أي أنّ الاتساق النصّي يكون حاضراً في الفعل التأسيسيّ للنصّ المكتوب، ومن خلال هذا الباب نلاحظ أنّ الانسجام الذي يظهر في النصّ، ما هو إلا نتيجة استدلاليّة أو سننيّة؛ فالنصّ الذي ينتمي إلى اللغة، ينتمي إلى التشفير، وليس هناك من النصوص التي تتكوّن خارج السنن أو المبرّرات والبراهين النصّية، وخصوصاً عندما نكون في عدّة مناطق من المناطق الوظيفيّة ذات الصيرورة الديناميكيّة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
1- الإدراك الحسّي عند ابن سينا – د. محمد عثمان نجاتي – ط3، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر – ص 39.
2- ابن سينا – كتاب الشفاء، ج 1 – ص 289.
3- الوظيفة والبنية – ص 35 – د. أحمد المتوكل – منشورات عكاظ، الرباط لسنة: 1993