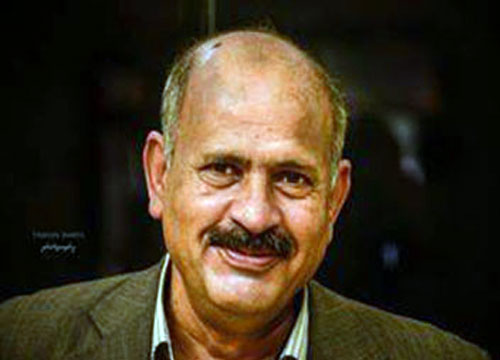الانسان المتفرد عن سواه بوعيه للعالم المعيش، يبحث دائما عمّا يُعينُه على التكيّفِ مع ضراوة العالم، بوسائل منتجة وقادرة على إدامة تواصله في العيش الملائم وبأقل الخسائر. وهو جرّاء هذا الوعي -المبتلى به- غير متوافقٍ مع مجريات الواقع المربكة لحياته وحياة الآخرين. فنراه حتما دائمَ التمرّدِ على الثابت والراسخ والمتوارث منذ القدم، ولكن بأساليب متباينة، تبعا لطبيعة الفرد وقدراته على استيعاب ظروفه المحيطة. وتلعب التربية والتعليم والبيئة والمكتسبات القيمية والثقافية، دورا فاعلا ومؤثرا في تخصيبه بالممكنات اللازمة والضرورية لصقل شخصيته. وهذا ما يمنحه القوةَ والعزم على مواجهة عراقيل ومصدات الدرب الذي اختاره، لتحقيق أهدافه الفكرية وتطلعاته الإنسانية، لبناء مجتمعٍ مدنيٍّ متحضر.
ومن المؤكد أنه في سلوكه القائم على توجّهٍ ثقافيٍّ معين، لا يخلو من الاهتمام باختصاص ثقافي يتميّزُ به، على وفق ما عرفه واكتسبه وجربه من الثقافة بكل تنويعاتها ومستوياتها المتعارف عليها. ونحن نرى أن الآداب والفنون والعلوم الإنسانية والتطبيقية، هي من أرقى الثمار التي انتجتها البشرية على مرّ العصور. والأديب وكذلك الفنان، يحاول كلٌّ واحدٍ منهما، وعبر منجزه الإبداعي أن يبتكرَ عالما خياليا تعويضيا عن عالمه الحالي غير المرضي له ولمجتمعه. وذلك من خلال انتقاده وتمرّده على كل الأنساق المتسلّطة والقامعة لأيِّ تطلّعٍ للتحرّر والتقدم صوب مستقبل آمن. (إنَّ شكلا من أشكال الفن هو تعويضٌ عن عدم الرِّضا من الحياة، وهو خلقُ عالمٍ خياليٍ مُرْضٍ، وخلقٌ لحقيقةٍ أخرى تهدفُ لأنْ تحُلَّ محلَّ الحقيقة: إنهُ استبدالُ العالمِ الحقيقيِّ المُتعَبِ بعالمٍ آخر أكثرُ إرضاءً)1.
وها نحن الآن نقف أمام منجزٍ إبداعيٍّ أثبتَ حضورَه، ألا وهو الرواية، وهي كجنس أدبي يستوعب كل الأجناس (الأدبية وغيرها) لأنها معمارٌ لغويٌّ كبيرٌ ينفتح على كل الجهات. وهي بحاجة الى مخيلةٍ حافلةٍ بتجارب متواصلةٍ في تعاقبِها لتكريسِ وتسويقِ مشروعٍ كتابيٍّ، يواجه المتلقي بنصٍّ ذي منظومة بثٍّ مغرية له، على التواصل القرائي ومن ثمَّ التأويل. ولا ننسى أن المنجزَ الإبداعي عموما، لا يخلقُهُ إلّا منتجٌ جادٌّ، يتوفر على خزينٍ معرفيٍّ وتجربةٍ حياتيةٍ ثريةٍ، كي يكونَ منجزُه جديرا بالانتباهِ والاهتمام. والرواية تحديدا - وفق ما نراه - هي خيرُ معبّرٍ عن راهنِها عبرَ الزمن، فهي تكشف بصدقٍ وحياديةٍ عن الحوادث وتداعياتها، كي تتعرفَ الأجيالُ اللاحقة على عالمِ الأسلافِ دون زيف. لأنه في قراءة الموروث، يجب البحث في بياض المدونات وفيما وراء الكلمات.
وفي رواية (مكابدات مريم) لـ حنون مجيد الصادرة عن (منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق) ط1/ بغداد 2024. سنعمل إجراءً فاحصا، عبر خمسة كولاجات تأويل لكل ملمحٍ لافتٍ في النص، يتبعها ملحقٌ رؤيويٌّ، وكما يلي:
بِنية الراوي/ كولاج تأويل أول:
الراوي، بنيةٌ سردية يبتكرها ويخلقها الكاتب لتبيان مفاصل حركة السرد أمام القارئ، وشخصية الراوي تُرسَمُ وفق رؤيةِ الكاتب وأسلوبِه وأهدافِ خطابِه السردي. وها نحن الآن، أمامَ نصٌّ روائيٌّ يلعب فيه الكاتب دورا مهما وأساسيا في عملية السرد، فهو (الراوي العليم) العارف بكل شيء. والجسد الروائي الماثل بكل أبنيته السيميائية والدلالية، خرج من مخيلتِهِ المكتنزةِ على جميع نصوص ما قبل التدوين. وهو من صاغ بنية السرد بدراية تامة، لأنه من داخل الحكاية، ومشاركٌ فيها، وتقمّصَ أدوارَ رواةٍ عدة. وعلى الرغم من أنه لم ينطقْ بضمير المتكلّم كشخصية، غير أنه مشارك في شخصية (صاحب مكتبة آفاق) وكاتب رواية (مملكة البيت السعيد) أيضا. إنَّ بنية الراوي توزّعت لعدة أصوات، وتباين مستوى حضور أو تأثير الكاتب في كلِّ شخصية.
البنية اللغوية / كولاج تأويل ثانٍ:
من المعروف أنَّ البنية اللغوية السردية، تشمل المستوى (الصرفي والتركيبي والصوتي والدلالي) ونجاح أداء هذه المستويات، هو ما يحدّدُ مدى كفاءة النص الروائي أمام المتلقي. وقد لمسنا نجاحا لافتا في سلامة النحو، بالامتثال لقواعد اللغة العربية، وهذا نتاجُ الخبرةِ المستمدةِ من اتساعِ وعمقِ التجربةِ. كما أنَّ متنَ النصِّ المشكَّلِ من مفرداتٍ وتراكيبَ وجُملٍ ومقاطعَ، تَوفَّرَ على نسقٍ جماليٍّ أخّاذٍ ومؤثرٍ اتصاليا. بينما تبارت الكلمات والمفردات فيما بينها لبثِّ منظومةٍ صوتيةٍ كَسَبَتْ وِدَّ المتلقي، وذلك لجزالةِ توصيلِها لأصواتٍ مستساغةٍ من أذنِ المتلقي. ولمهارةِ الكاتبِ دورٌ بيِّنٌ في انتقاءِ مفرداتٍ ومن ثمَّ جُملٍ مُجديةٍ في انزياحِها الدلالي، لما تنطوي عليه من بلاغةِ بساطةٍ، لا بلاغة معجم، وهذا دليل على دربةِ مخيلةٍ أكسبَها المرانُ حسنَ التوجّه.
البنية السيميائية/ كولاج تأويل ثالث:
كشفَ لنا الاطّلاعُ المتبصِّرُ في جسد النص، أنه معمولٌ عبرَ تجزئةٍ للمتنِ ومجاوراتِه بنسقٍ يتيحُ للقارئ، فرصةَ الانتقال من جزءٍ الى آخر برويّةٍ، وذلك لفهم جميع الأجزاء بالتّعاقب. كما تَزَيّا المتنُ بمقاطعَ نصّيةٍ من رواية الكاتب (مملكة البيت السعيد) كيما يشيرَ الى التواصلِ الثِّيمي والتاريخي بينهما، وهي لعبةٌ كتابيةٌ تُحسَبُ له. أن متانةَ البنيةِ السيميائية أو العَلاميةِ لهذه الرواية، اعتمدت على العلاقة الإيحائية التداولية بين الدال، أي إسم الشيء (مفردة/ إشارة/ رمز/ لوحة/ كتلة/ وسواها) وبين مدلولِهِ أي معناه. واعتمدت أيضا على جودة التصميم الهندسي للنص (متنا وملحقاتٍ) والذي تحلّى بانزياحاتٍ تشكيليةٍ وفسحٍ ريازيةٍ، عَملتْ على تخصيبِ منظومةِ البثِّ بقيمٍ جمالية، أغْوتْنا على تفكيكِ مكوّناتِ بنيتِهِ السيميائية، للتعرّفِ على أعماقِ بنيتهِ الدلالية.
البنية الدلالية/ كولاج تأويل رابع:
البنية الدلالية للنص، تخرج من رحم البنية السيميائية، وفيها نَكتَشِفُ كنوزَ مضامينَ متناسلةٍ لمضامينَ محتملةٍ وهكذا، لننشغل بانشطاراتِ معانٍ لا تُحصى. فالنص الروائي بتعدُّدِ تمظهراتِه العلامية، يوقعنا بشبكةِ مساربَ دلاليةٍ - أفقيةٍ وعمودية- مزدانةٍ، بجنائنَ مدلولاتٍ هي حلولٌ لشفراتِ الدَّوال. وتكتنزُ الروايةُ بسردياتٍ مشفّرةٍ، تتطلّبُ مشاركةَ القارئِ في البحث عن حلولٍ ممكنة لها، وكمثال على ذلك هو رسالة فاطمة ص153. وليس أمامنا سوى الانصياعِ لهكذا تقنيات كتابية مراوغة ومشوقة في آن، تومئُ لكاتبٍ ذي مهارةٍ مكتسبةٍ من اختمار مشروعه السردي. كما أن حركة السرد المركزية المتمثلة في كارثة مريم، تفرّعَت الى سرديات صغيرة شتى، لتُعَبِّرَ عن صبرِ مريمَ ونبلِ مشاعرِها، وهي تشارك الآخرين في همومهم.
بنية الحدث/ كولاج تأويل خامس:
الحدث هو الواقعة الخارجة عن المألوف، والتي تجري في (زمكانية) معيّنة، أو تتداعى الى (زمكانيات) متعددة، وبنية الحدث في السرد تقوم على التكثيف، والتجريد، والتّخيّل المتحرُّرِ عن الواقع. والنص الماثل الآن، ينطوي على بِنى سيميائية ودلالية، يتشكلُ معمارُها - خلالَ حركةِ السردِ - بروابطَ يحكمُها منطقٌ فنيٌّ خياليّ، لا واقعي. فالأحداثُ في النص، تجري وتتعاقبُ دون التزام تقليدي بأزمنة وأمكنة العالمِ القائم، بل حسبَ متطلّباتِ المشغلِ السردي للمخيلة. فشخصية مريم تتأثر بأحداثٍ سرديةٍ تنبثقُ بين ضرورةِ سردٍ وأخرى، تبعاً لتواصلِ تطوّرِ ايقاعِ حركةِ السرد، درءا لرتابة النص المفضي الى ملل المتلقي. إنَّ بِنى الأحداثِ أو الأفعالِ السردية، خُلِقَتْ كنتيجةٍ لأخطرِ أحداثِ الواقعِ المرير (الحروب المتناسلة) ولطغيانِ تداعياتها على المجتمع.
ملحق رؤيوي:
بعد كولاجاتنا أعلاه، نقف عند بعض التماعات عمل الكاتب، والتي خصَّبَت النصَّ بتوهجاتٍ جماليةٍ مؤثِّرةٍ أدائيا، مِمّأ يستدعي أن نوجّهَ لها مجساتٍ رؤيويةً فاحصةً. وكما يلي:
- في ص5، نقرأ (العراق هو أسلحة الدّمار الشامل، وقد عثروا عليهِ ودمَّروهُ) وهي جملة مقتبسة، لكنّها تهكمية، واشهارية الاحتجاج، على تدمير كلَّ شيءٍ في البلاد. الروائي كتب هذه الرواية وما قبلها عن معايشة لمجريات لا تُطاق، معتمدا على تجربةٍ (حياتية/ كتابية) ومنطلقا من وعيه التام بحجم الخراب الاجتماعي، حيثُ تفشّي الكراهيةِ، وطغيان شريعةِ الغاب.
- وفي ص210، نقرأ (لا تجزعي مريم.. أمامَكِ عِجافٌ أخرى) وهذا كشفٌ لموقف مريم الرافض لأمِّها فاطمة التي ولدتها ثُمَّ باعتها، لتستمرَّ في مواجهةِ مصيرِها الكارثيِّ المفتوحِ على المجهول. وهنا يكتمل معنى، ووجود الرواية (وذلك لأن وجود الرواية بالذات هو الحلقة الأخيرة في سلسلة حلقاتِ حبكتِها)2 حسب تودوروف. وبهذه النهايةِ المفتوحةِ على المستقبل، يورِّطُنا الكاتبُ كي نشاركَهُ في البحث عن أفضل نهاية، من شتّى نهاياتٍ محتملةٍ للنّص.
- أمّا في ص40، أدهشنا الكاتب باللعبة الكتابية اللافتة، التي أجراها في مقاربتِهِ المقارِنةِ بين البيت والدكان، والتي ربط بينهما وبين شخصية أبي ليث، المحبوب والعصامي والمعطاء للناس والمحلة والوطن.
- بينما في ص 79، يقوم بإعادة كتابة جزء من فصل روايته الذي سرقته مريم، في صِغَرِها من مكتبته، وهذه التقانة السردية، تُطْلِعُنا على الكيفية التي كان (يكتبُ وينضّدُ) بها، صفحاتِ وفصولَ الرواية (من بين وخلال) الأحداث والمجريات اليومية. كما أنه في الصفحات 128 و129 و132، تناول برؤيةٍ ثاقبة، ما واجهته بغدادَ من خساراتٍ وانكساراتٍ في البنيتينِ التحتيةِ والفوقيةِ. وتعدَّدَتْ آلياتُ التقنياتِ الكتابيةِ للنص الروائي (سيميائيا ودلاليا) والتي منحتْهُ ثراءً أدائيا خلالَ الاتصالِ بالمتلقي.
لقد مَثُلَ أمامَنا نصٌّ روائيٌّ صارمٌ في مقاضاتهِ، لسِفرِنا الاجتماعي (الفائت/ الراهن) لما اقترفَهُ من ظلمٍ فادحٍ ضدَّ البراءةِ والرِّقَّةِ والحبِّ والجمال، فالبراعمُ بلا محبةٍ ورعايةٍ وحنانٍ، لا تورق وروداً، بل أشواكا. والنصُّ بما ينطوي عليه من رؤى جماليةٍ - اجتماعيا وسرديا - يمثِّلُ وثيقةَ إدانةٍ لكل ما جرى من أحداثٍ مرعبةٍ، ومن تداعياتٍ كارثية. إنَّ الروائي (حنون مجيد) بكتابه (مكابدات مريم) نجح فعلا في اغوائنا على التواصل القرائي معه، إذْ نقلَنا من عالمِنا الفوضوي الواقعي، الى عالمِ الخيالِ السرديِّ المحرجِ لنا، والمربكِ لتلقّينا، بمراوغاتِهِ الكتابيةِ المُعَرّيةِ لزيفِ وجودِنا، والفاضحةِ للأوبئةِ المنتشرةِ في النسيج الاجتماعي. وتَبيَّنَ لنا فعلا، أنَّ (النَّصَّ ليس مكاناً للأمان أو الاستقرار. كما أنَّ القراءةَ ليست هروبا من عالمٍ فوضويٍّ لا معنى له، ولكنَّها إدخالٌ في عالمٍ آخر)3 حسب أيرن فيشون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إشارات
1- كتاب (نصوص فلسفية مختارة) أرمان كوفيليه/ بيت الحكمة/ بغداد 2006/ ص368.
2- كتاب (خمسون مفكرا أساسيا معاصرا) جون ليشته/ المنظمة العربية للترجمة/ ط1 بيروت 2008/ ص319.
3- كتاب (جماليات ما وراء القَّصّ) مجموعة مؤلفين/ دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع/ دمشق 2010/ ص85.