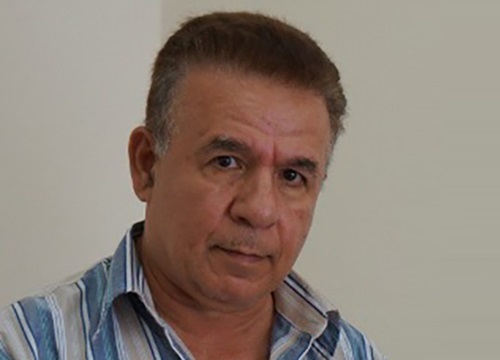إنّ الاستعانة بالعقل والمنطق تعد سمة من سمات الكتابة السياقية، والتي تميل أيضاً إلى المتعلّقات الدلالية وذلك لكي تأخذ البراهين والاستنتاجات في الجمل التي يرسمها الباث طريقا أوّلياً، وهي بكلّ تأكيد متعلّقة باللغة، فالانحياز اللغوي خير دليل على التواصل معها، وخصوصاً إذا كانت لغة نصّية ذات علاقات داخلية وخارجية؛ والغاية منها تأطير النصّ بما يلائمه من مفردات وجمل وتعابير ومركّبات، فيكون الالتزام بالاستدلال بكلّ أنواعه قد أخذ مساحته الجدلية، وتوظيف المساحة الجدلية في النصّ المكتوب، بسبب البناء كهدف تواصليّ بالتسلح بالحجاج وذلك للتأثير والإقناع والحوار. والهدف من هذا كلّه أن نذكر أنّ الكتابة النسقية ؛ كتابة منطقية، حجاجية وجدلية وحوارية، ويكون الحوار الحِجاجي ذا أنواع مختلفة، ويدخل معنا على هذه الخطوط الرأي التشكيلي الذي يهمّ المتلقي (سياق المتلقي)، والذي يكون إمّا على شكل علامات موجّهة أو شيفرة لغوية ضمن السياق الكتابي (إذا كانت المقاربات البنيوية قد تعلقت بوهم النسق المغلق والتحليل المحايث فإنّ المقاربات السيميائية استطاعت أن تتجاوز هذه الحدود الضيّقة لترتقي بها إلى منزلةٍ انبثق منها خطاب واصف Métadiscours تمثلت وظيفته في البحث عن الأنساق السيميائية الدالّة بمستوياتها اللسانية وغير اللسانية. وهذه الأنساق لم تفصلها السيميائية عن إطارها الاجتماعي العام والملابسات التي أحاطت بنشأتها؛ وذلك ما تنبأ به دي سوسير في محاضراته حول اللسانيات العامة “ 1 “).
تعد السيميائيات من الأنساق الدالة، دلالياً ومعرفياً، حيث أنّ التأويل صيغة رئيسية في المنظور النصّي، لذلك فالسيميائية عندما تدرس النوع ومنها النوع الأدبي فإنّها تقودنا إلى أنساق دلالية وآليات تأويلية، ومن هنا من الممكن أن نوضّح الدوال النصّية، حيث يكون التشفير النصّي سمة من سمات الرموز والتي تتخاتل في المنظور النصّي إذا ما اعتمدنا السيميائية كمنهج سببي. وإذا ما أخذنا الناحية الجسدية، فيكون نظام الإشارات الدالة هي الأقرب في توضيح الجمل التواصلية في النصّ؛ فهناك الإشارات المتعلقة في ذهنية الإنسان ومنها إشارات اليد والأصابع وحتى حركة الإنسان واتجاهاته، وهناك العلائق الدلالية غير اللفظية ومنها السمع والبصيرة.
التعلق الدلالي:
كلّ نصّ من النصوص يحوي على حركتي الدال والمدلول، ويكون للتأويل مساحة حركية من أجل أن تكون الدوال خلايا بنائية متعدّدة الاتجاهات، لذلك تظهر في النصّ بعض المتعلقات الذاتية، وهي الجزء الأكبر من التفكّر الذي ينعكس على النصّ المكتوب عندما يكون الباث قد فقد الصور المباشرة وراح يستدعي المدلول من خلال الصورة الذهنية؛ حيث تكمن الطبقة الخصبة للمعرفة الدلالية والتي تلتف حول المعاني المؤولة، وكلّما كبرت المعاني تكبر الدلالات وتتعدّد المفاهيم.
في المفاهيم الدلالية ومن خلال الاستدعاء الذهني يكون الباث بين اتجاهين، الأوّل من خلال الدال، والثاني من خلال المدلول، وهكذا تكون المعاني قد التمت وخصبت في الحكم الدلالي المعرفي.
الصورة الذهنية = الدال... الصورة الذهنية = المدلول
“ 2 “
كما أنّ أمر الدلالة يقودنا إلى أمر كلّي وأمر جزئي، يلتقيان في المعنى الكلّي للدلالة أو يبنيان نفسهما في الأمر الجزئي للدلالة، ومن هنا، يعتني المؤلف بأمر الدلالة وحركتها، كأن تكون من خلال الدلالة المعرفية أو الدلالة التموضعية والتي شغلت منطقة حديثنا في التعلّق الدلالي.
الكتل الدلالية:
تمتلك الكتل الدلالية القدرة على التأثير، لذلك فهي حديث الوقائع التداولية وإعادة توظيفها بمنظور كتابي – لساني، واللغة بطبيعة حالها تمتلك وظيفة حجاجية، إذن هناك السببية التي تعتني بالنصّ، وهناك نتيجة العبارة أو الجملة التي تتقبل الاندماج الكتابي، أيّ أنّ هذه الوظيفة هي مجمل الأقوال نفسها، ومنها القول الكتابي، والذي يشكّل أهمية اندماجية، واندماجية المشهد للمعنى أيضاً، ومن هنا نخرج عن القول بأنّ (وظيفة اللغة هي وسيلة تواصلية – إخبارية)؛ لذلك فالفرق يكمن بين وظيفة الحجاج القديمة والتي تعتمد على النتيجة ووظيفة الحجاج الحديثة التي تعتمد على التأويل.
إنّ الكتل الدلالية أو الالتحامات الدلالية، ساعدت نظرية الحِجاج على مساحة التأويل، لذلك فإن {أهم ما تؤكده نظرية الملتحمات الدلالية في نظر “كاريل” هو أنّ العلاقة بين وحدات الخطاب المتضامنة في المسلسلات الحجاجية هي بالأحرى علاقة اختصار (وهو ما عبّر عنه ديكرو بالوصف والتأشير...)، فلو أخذنا أي عبارة وردت في هذه المسلسلة فإنّنا سنجدها تتضمّن في ذاتها، وعلى نحو مضمر، تلك الوحدات التي يفترض أنّها تقبل التآلف معها في مسلسلات حجاجية، فهذه الوحدات كامنة في تلك العبارات، لأنّ هذه الأخيرة ما هي إلا صورها المختزلة التي يمكن بسطها عبر إجراء التأليف، وهذا الإجراء يسمح بتمديد هذه العبارات وتحويلها من صورة مختزلة إلى مسلسلات مطوّلة. “ 3 “}.
تساعد حركة الأفعال التي من الممكن أن تكون من ضمن الكتل الدلالية (تعدّد الأفعال الحركية والانتقالية) على امتداد الجملة داخل النصّ المصغّر، وقد يحوي هذا النصّ على عدة عبارات (امتدادية) أيضاً، وقد يكون على صيغة جمل تساعد الواحدة الأخرى من ناحية التأويل أو تأجيل المعنى، لذلك يكون هناك الربط بين نصّ ونصّ آخر في مواضع عديدة، ولكن تحت مسمّى واحد.
لا نستطيع أن نؤيّد بأنّ كلّ المعاني دلالية، ولكن القاعدة الدلالية التي تربط لغة النصّ بنصّ آخر، هي التي تعمل على توزيع المعاني وتدجينها في الوحدات النصّية، وهنا نؤكّد على الوحدات النصّية والتي تقيم علاقات دلالية في المنظور الكتابي.
الوحدات الدلاليّة: من الاختلافات التي تواجهنا موضوع الوحدة الدلالية في النصّ؛ وتُعد الكلمة المفردة الحاملة للمعنى أصغر وحدة دلالية تواجهنا في النصّ المكتوب؛ ولكن ماذا عن الوحدة الدلاليّة اللغوية؟
تتواصل الوحدات الدلالية من خلال علاقاتها مع اللغة وعلاقتها مع المعاني، وتغيير المعنى يظهر من خلال حالات التركيب التي تحتاجها الوحدة الدلالية، أو بالأحرى هي قصدية التأويل ودمجه في حالات فلسفية. وتختلف وجهات النظر بخصوص الوحدة الدلاليّة اللغوية؛ بتعريف الوحدة الدلاليّة فمنهم من قال: إنّها الوحدة الصغرى للمعنى. ومنهم من قال: تجمع من الملامح التميزية. ومنهم من قال هي امتداد من الكلام يعكس تبايناً دلالياً “ 4 “ ومنهم من أكّد؛ بأنّها أصغر وحدة في بنية الكلمة تحمل معنى أو تؤدّي وظيفة نحوية “ 5 “
قد تقونا الوحدة اللغوية إلى ما بعد المعنى، وألا يكون للوحدة اللغوية استقلالاً يذكر وذلك لأنّ الوحدات المركّبة والتي تتّصل بالمعاني هي وحدات صغرى (ونقصد بالوحدة اللغوية الصغرى، تلك الوحدة التي لا تتقبّل التجزئة دون الإخلال بالمعنى)، ويقصد هنا بالمعنى؛ المعنى الوظيفي. والدلالات الوظيفية وعلى صيغتها المستخدمة تبدأ من الكلمة المعجمية (أصل المعنى) وتنتهي بالضمة التي تعانق الكلمة.
إنّ الوحدات اللغويّة هي التي تقودنا لكي نصل إلى المعاني، ولكن عندما تكون الجملة امتدادية في اللغة، تتنوّع التأويلات، وهي الحاملة للمعاني، إذن نكون في منطقة واحدة في جميع الأحوال هي منطقة المعنى التي نسعى للوصول إليها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر
1 - د. أحمد يوسف – القراءة النسقية، سلطة البنية ووهم المحايثة – ط1 لسنة 2007م، منشورات الاختلاف، الجزائر – ص 113
2 - من وجهة نظر عقلية صرفة، توصّل الفيلسوف الأمريكي بيرس Pierce إلى تقسيم ثلاثي للعلامات يقترب من أنواع الدلالات عند العرب. فتقسيم العلامة إلى شاهد Index وأيقونة Icon ورمز Symbol. الذي شاء من بعجه في السيمياء الحديثة، يشبه ولا شك أنواع الدلالات الثلاثة، أعني العقلية والطبيعي والوضعية. كما أنّ هناك أكثر من جانب تقارب بين نظرية الدلالة عند العرب والسيمياء عند بيرس. – علم الدلالة عند العرب، دراسة مقارنة في السيمياء – تأليف: عادل فاخوري – ص 13
3 - مفهوم الموضع وتطبيقاته في الحجاجيات اللسانية لأنسكومبر وديكرو، مجلة عالم فكر، - ص 227 العدد 40 - رشيد الراضي - لكويت 2005.
4 - علم الدلالة – د. أحمد مختار عمر – ط5 لسنة 1998م، القاهرة
5 - الصوت المركّب في المشترك السامي – حازم كمال الدين – دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة 2006م.
*علاء حمد: عراقي يقيم في الدنمارك