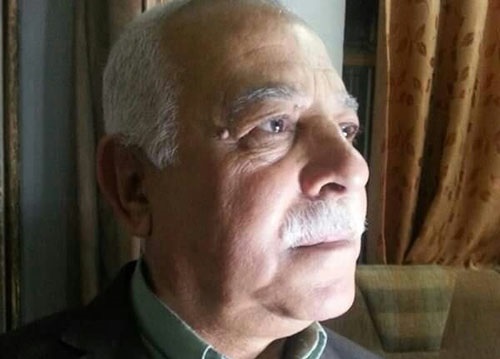حدث هذا منذ سنوات.. سنوات عديدة، ليس بوسعي تحديدها أو ضبط إيقاعها، لكن ما حدث بقي راسخاً في ذاكرتي.
كنت تلميذاً ناجحاً ومحبوباً من المعلمين ومن زملائي.. وكان معلم العربية الأستاذ ادريس أفندي يخصني بإهتمامه لأتقاني المادة قبل غيري من اقراني..
إلا أن ما لفت نظري أن ادريس أفندي، كان شديد الحزم مع زميلي حنا..
كان يؤنبه ويقلل من شأنه مراراً، ويضربه بعصا غليظة كان يحملها دائماً معه، لكنني لم أشاهده يضرب أي منا، باستثناء زميلي حنا.
كان يسخر منه، ويشجع تلاميذ الصف على إهانته وتهميشه.
لم يكن حنا كسولاً ولا مهملاً في أداء واجباته المدرسية.. بل كان متفوقاً علينا.. غير أن استاذنا ادريس، لم يكن ليرضى ابداً عن إجاباته على اسئلته في الصف ولا اجوبته على ورقة الامتحان.
كان حنا يحتمل كل هذا الجفاء بينه وبين ادريس أفندي.. وبتنا نخفف عنه نحن زملاءه، عندما أدركنا أن الحق معه، وان استاذنا يتجنى عليه وينال منه، من دون سبب يذكر..
وقد اغتنمت لحظة كان فيها الأستاذ يثني علّي.. فبادرت وسألته:
- أستاذ، إجابات حنا جيدة في كل الدروس، وأنت تقسو عليه.. لماذا؟
- اعرف، اعرف أنه تلميذ جيد ومتفوق، ولهذا السبب أكن له الكراهية والعداء، هذا النصراني.. مجتهد وسيواصل دراسته، حتى يصبح طبيباً، ربما يعالج ابنتي أو أختك.. هل يرضيك أن يكشف على جسد أختك نصراني.. ها...؟
ولم أجب، بقيت أحدق في وجه معلمي وأنا في دهشة وغرابة لما أسمع.. واصل ادريس أفندي كلامه:
- أنا أقسو عليه، حتى أجعله يمّل ويكره الدراسة، ويترك المدرسة.. هؤلاء النصارى، حريصون على أن يتفوقوا علينا، وهذا لن نسمح به، ولن نتيح له الفرص، شرفنا أغلى من كل شيء.
كانت كلمات استاذي خشنة وحاسمة ولا تقبل النقاش..
كان هذا قد حدث وأنا في طفولتي، وعندما كبرت وأصبحت معلماً، وتم تعييني في قرية نائية مع زميلين، نعيش سوية ونشترك في غرفة واحدة ننام ونأكل ونستحم فيها.. حدث ما لم أكن أتصوره.
طلب المعلم وسام من زميله المعلم حمدون، أن يستمع إلى مذياعه الترانزستر..
- من فضلك، إرفع صوت الراديو حتى نستمع الى الاخبار والأغاني سوية.. إلتفت إليه حمدون أفندي وبحزم خاطبه:
- عندما تدفع ثمن البطارية.
ضحكت بمرارة..
سارع حمدون:
- لماذا تضحك يا سعد..؟
جردني من كلمة أستاذ سعد، في وقت كنت أخاطبه دائما بأستاذ حمدون..
- البطارية ثمنها زهيد
- ادفعه انت.
- أدفع الثمن بكل سرور، ولا أريد الاستماع إلى مذياعك.
- تريد أن تتفضل علّي.. أنا لا أقبل صدقة من أحد.
كان الحوار عقيماً، ولم تكن بي رغبة للدخول معه في حديث آخر..
كنت انظر في وجه الأستاذ وسام، كما لو أنني أبحث عن تعليق.. لكنه بقي ساكتاً..
وفي الأيام اللاحقة، تجنبت فيها الدخول في علاقة معمقة مع أي منهما.. وانصرفت إلى قراءة كتب فكرية وروايات، كنت أجدد المجيء بها إلى القرية..
وذات عصر، وصلت القرية عائداً من المدينة، حاملاً كتباً جديدة وطعاماً يحتمل البقاء لعدة أيام.. أشارك فيه زملائي.
لكنني فوجئت بمنظر غير لائق، لم أكن أتوقعه أبداً.. أبداً.
شاهدت الأستاذ حمدون، يرفع ثيابه، ويتبول في صفيحة الماء التي كنا نضعها فوق مدفأة علاء الدين، ونستحم فيها.. فيما كان الأستاذ وسام مغادراً الغرفة..
لم يحس حمدان بالخجل، ولم يبُد عليه أن وجودي كان مفاجأة لم يحسب حسابها.. وقبل أن اسأله عن فعلته، قال:
- اغتنمت فرصة ذهاب وسام خارج الغرفة.. هذا الصابئي اللعين، لا يستحق أن يستحم في ماء طاهر ونظيف.. إنه شخص كافر، ولا بد من معاقبته.
ولم أجد سبيلاً للحوار مع هكذا كائن.. وإنما عجبت لنفسي، كيف يمكن العيش معه في غرفة واحدة؟
كنت أحس بالقرف، وافتعلت حركة سريعة، سكبت فيها ماء الصفيحة الحار الذي أعده وسام للاستحمام..
استاء وسام لماء كان قد أعده حتى يسخن، مثلما استاء حمدون لأن خطته في الإساءة لزميله قد فشلت.
وفيما اعتذرت لوسام، حدقت في عيني حمدون من دون أن يكترث لنظراتي..
وجلسنا نحن الثلاثة، نتناول الطعام الذي جئت به من المدينة.. وفي داخلي أسئلة تقول: كيف يمكن أن نأكل وننام ونضحك سوية وفي داخل بعضنا كل هذه الكراهية؟
مرت سنوات.. انتقلت فيها إلى المدينة، وجدت فيها روحي أكثر رحابة وألفة..
غير أنني فوجئت بسؤال سائق سيارة الأجرة التي استقلها، بعد أن دار بيننا حديث عن الغلاء والبطالة وتلوث المياه وغياب الكهرباء.. سألني:
- هل أنت كردي.. لهجتك، لهجة كردية.
حدقت في وجهه..
- لست كردياً، ولكن ماذا لو كنت كردياً؟
- أكرههم.. إنهم عنصّريون.
- ولكن كلامك.. كلام إنسان ينظر إلى الآخرين بعنصرية.
ضجر السائق من كلامي.. وراح يعبر عن غضبه..
- والله، لو أن أحداً، اعطاني عشرين دولاراً، وطلب مني قتل أي خصم له.. لفعلت بكل سعادة وسرور..
صدمتني هذه الكلمات، واحترت.. ماذا أجيبه، ولم أجد من سبيل سوى سؤاله:
- وما ذنب إنسان لا تعرفه.. وتعمد إلى قتله؟!
- العشرون دولاراً ستجعلني أعرفه.
لم يكن قصدي معرفة القتيل وإنما براءته وجهل القاتل بحقيقة أمره.
حدقت في وجه السائق القاتل.. وجدته قاسياً، صارماً، جافاً، سمرته دالة على أنه قد إعتاد القتل، وأنه يستسهل الأمر.
لم تكن بي قدرة على احتمال الجلوس إلى جانب قاتل.. دفعت له أجرته، وطلبت إليه الوقوف.. حتى انزل.
- لم نصل بعد إلى مكانك!
- تذكرت أن لي صديقاً هنا.. مريض ولا بد من زيارته..
حدق في وجهي بكراهية لا فتة.. توقف عند طريق ترابي.. وحال فتحت الباب، باب السيارة، سمعت، سمعت صوت ثلاث إطلاقات باتجاهي، ولم أكن اعرف إن كانت قد أصابتني احدى الرصاصات أم لا، أم كان القصد مجرد إخافتي.. فيما كانت السيارة تسير مسرعة، غير أن الناس الذين تجمعوا حولي، بعد سماعهم صوت الإطلاقات طمأنوني:
- حمداً لله على السلامة.. الإطلاقات لم تصبك..
ومنذ تلك اللحظة انصرف ذهني للبحث عن مكان.. مكان آمن تسوده المحبة..