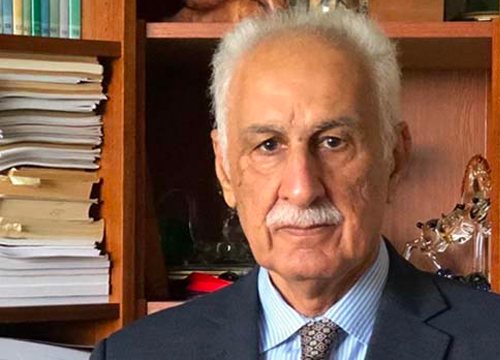خلافا للرئيس (جورج بوش الأب) الذي كان كان على قناعة أن القوة العسكرية هي الأساس في صياغة الاستراتيجيات الأمنية، فقد تغيرت آراء الإدارة الأمريكية بقدوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الثاني والأربعين (بيل كلينتون Bill Clinton)، والذي أكد على أن امتلاك القوة العسكرية وحدها ليس كافيا للمضي قدما في قضية الانفتاح العالمي، لذلك أصبحت القوة الموسّعة السمة المميزة للسياسات الأمنية الأمريكية خلال التسعينيات من القن العشرين. إلا أن ذلك لم يسهم في تجنب الحروب أو التقليل منها، فقد أكدت لجنة مختصة في صياغة الأمن القومي في تقريرها عام 1999على أن الولايات المتحدة ومنذ نهاية "الحرب الباردة" اشتركت في أكثر من (40) تدخلا عسكريا مقابل (16) تدخلا فقط خلال فترة "الحرب الباردة" بأكملها.
بالمقابل، أظهرت إدارة كلينتون حرصا شديدا على ترويج قناعتها بأن صياغة إستراتيجية متكاملة جديدة لا يكفي لوحده، بل يتعين أيضا تبيان مبرراتها للشعب الأمريكي. لأجل ذلك كان لابد من استبدال الهدف المنفرد الذي مثله "احتواء الشيوعية" بمسوغات أكثر تشابكا بحيث تنسجم مع الحقبة الجديدة، وتحقق بالتالي خلاصة مختلف الرؤى حول دور الولايات المتحدة في عالم ما بعد الحرب الباردة، وتوفّر قاعدة مفاهيمية صلبة للسياسة الخارجية للإدارة الجديدة.
لم تظهر هذه الرؤية الجديدة، حينها، بشكل أكثر وضوحا من ظهورها في أوربا، ففي قلب هذه الإستراتيجية تظهر إرادة الأمريكيين في التعامل مع ضمان أمن القارة الأوربية كهدف استراتيجي غير قابل للتحول. غير أن التحول طال أبعادا أخرى تمتّد من الدوافع، إلى طبيعة هذا الهدف، مرورا بطرق ووسائل تحقيقه في الفترة الجديدة.
فخلال حقبة "الحرب الباردة"، كانت المصالح الحيوية للولايات المتحدة تتحدد في إطار مواجهة "التوسع الشيوعي". وفي هذا الإطار، مثّل ضمان أمن أوربا الغربية التزاما استراتيجيا حضي بالإجماع وأعطيت له الأولوية، كونه كان يمثل مصلحة حيوية أمريكية لا يتطلب تبرير خصوصيتها وأهميتها عظيم الجهد. ولكن نهاية الحقبة المذكورة أحدثت تقّلبات جيوسياسية عميقة وواسعة، ثم أن أوربا أصبحت فضاء جيوستراتيجياً يختلف كثيرا عن فضاء "نظام يالطا".
وبالملموس فإن تفكك الاتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الاشتراكي وضع سياسة الولايات المتحدة تجاه أوربا أمام مفارقة ظاهرة؛ فمن جهة، هناك تراجع حقيقي للتهديد الشامل، ولكن هناك أيضا تراجع للسلم إضافة الى تنامي غير محدود للمخاطر وحالات اللاإستقرار في مرحلة تحولات صعبة وحاسمة وغير واضحة المعالم، لا يمكن للولايات المتحدة، لحسابات استراتيجية وجيوسياسية، أن تنأى بنفسها عن مراقبتها وإدارتها وتوجيهها - خصوصا في الجزء الشرقي من اوربا الذي شهد الانتقال المعكوس من الاشتراكية الى الرأسمالية - لأن ذلك سيكون له ثمن سياسي كبير وتأثير سلبي على مكانتها القيادية في هذا الفضاء الجيوسياسي الحيوي بالنسبة لها. ومن جهة أخرى، فانه في الوقت الذي كانت تزداد فيه القيود على الالتزامات الأمريكية الخارجية بسبب محدودية الموارد، أصبحت القوى الأوربية التي استفادت من نظام الأمن الذي ظلّ متمحورا حول الالتزام والحماية الأمريكية طيلة حقبة "الحرب الباردة"، منافسين حقيقيين ومحتملين للولايات المتحدة على أكثر من صعيد وخصوصا الاقتصادية منها. وهذا يعني أن استمرار تحمل الولايات المتحدة لأعباء الالتزام بضمان استقرار وأمن القارة الأوربية على نحو ما فعلته خلال نظام يالطا، سيكون في غير صالحها ضمن إطار هذه المنافسة، وسيعمق الاختلال ويوسع الفجوة بين قدرات أصبحت أقلّ توّفرا والتزامات صارت أكثر اتساعا. وكل هذه التحولات تطلبت جملة من التغيرات في السياسة الخارجية لمواجهة التحديات الجديدة والمتجدة. وقد عبر عن هذا التوجه رئيس دبلوماسية الولايات المتحدة (خلال فترة حكم بيل كلنتون) وارن كريستوفر Warren Cristopher قائلا: "لم تشهد بلادنا منذ أواخر الأربعينات تحديا كالذي تشهده اليوم لصياغة سياسة خارجية جديدة برمتها لعالم تغير بصورة أساسية، وكما كان عليه الحال لنُظرائنا في ذلك الوقت، فإننا بحاجة إلى تصميم إستراتيجية جديدة لحماية المصالح الأمريكية [...] و لابد لهذه الإستراتيجية من أن تعكس التغيرات الأساسية التي تتميز بها هذه الحقبة".
يمكن تقسيم فترة حكم الرئيس كلينتون الى قسمين او فترتين فرعيتين. ركّز في العهدة الأولى على القضايا الداخلية مع عدم التركيز (أو تركيز أقل) على السياسة الخارجية التي اعتبرها امتدادا للسياسة الداخلية، ولكن بالنظر لبعض التجاذبات بين مختلف المؤسسات السياسية الأمريكية وتبادل الأدوار، والتطورات العالمية، عادت القضايا الخارجية للبروز في العُهدة الثانية.
وقد اتسمت فترة رئاسة (بيل كلينتون) بغياب جدول أعمال واضح ودقيق لقضايا السياسة الخارجية ونادرا ما كانت الاجتماعات تبدأ وتنتهي في موعدها المحدد، وتتسم مشاركة بعض المسؤولين بالعفوية وبعضهم كان من المعنيين بالشؤون الداخلية، ومع ذلك يحضرون مداولات مجلس الأمن القومي، ولم يكن الرئيس الصوت المسيطر بل مجرد مشارك في النقاش.
بالطبع تستند أصول القوة غير المسبوقة – و التي لا تساويها قوة أخرى- التي كانت تتباهى بها إدارة بوش، إلى نهاية المرحلة الأخيرة من التنافس، أي "الحرب الباردة" التي امتدت خلال الفترة 1945- 1990. لقد أدت "ثورات" وسط وشرق أوروبا في 1989 وتفكك الاتحاد السوفيتي في 1991، بالولايات المتحدة إلى تبوء موقع القوة العسكرية القائدة في العالم. كما منحت هذه التطورات الرأسمالية الأمريكية منفذاً لمناطق كانت قبل ذلك مغلقة دونها بسبب تقسيم العالم خلال "الحرب الباردة" إلى كتلتين عظميتين متنافستين. وتعد وسط آسيا أبرز هذه المناطق، حيث تحتوي على احتياطات نفطية كبيرة وتحتل موقعاً استراتيجياً على الحدود بين مناطق النفوذ الروسية والصينية. بيد أن انهيار النظام الاشتراكي لم يوقف التنافس بين الدول الكبرى. وقد قال بعض الباحثين الذين لم يتأثروا بما قيل في زهو النصر حول نهاية التاريخ وبداية قرن أمريكي جديد، إن انتهاء الاستقرار المبني على الثنائية القطبية سوف يؤدي الى مرحلة جديدة من المنافسة الجيوسياسية العنيفة، وبالتالي إلى مخاطر وعدم استقرار أكثر مما كان في مرحلة ما قبل 1989.
وبشكل أكثر تحديداً، واجهت الولايات المتحدة مصدرين محتملين للمخاطر: جاء الأول من داخل المعسكر الرأسمالي الغربي، من ألمانيا واليابان، اللتين كانتا خاضعتين إلى قيادة الولايات المتحدة العسكرية والسياسية طوال "الحرب الباردة"، لكنهما تطورتا إلى منافسين مهمين للرأسمالية الأمريكية. إن تدهور المكانة الاقتصادية الأمريكية النسبية في مواجهة هاتين الدولتين كان أحد العوامل المهمة وراء دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من الأزمات في أواخر الستينات.
اما المجموعة الثانية من المنافسين المحتملين للولايات المتحدة في حينه فضمت دولاً من خارج المعسكر الغربي. فروسيا الاتحادية ظلت دولة عظمى برغم إفقارها ووقوعها في فوضى سياسية واجتماعية- اقتصادية. فهي تمتلك آلاف الرؤوس النووية وتمتد عبر "أوراسيا" وتضم أو تحد مناطق ذات احتياطيات كبيرة لمصادر الطاقة. ومع ذلك تبقى الصين التهديد الأهم نتيجة النمو الاقتصادي السريع الذي حققته والذي اعطاها الموارد الكافية لصعودها كقوة عسكرية عظمى في أكثر مناطق العالم عرضة لعدم الاستقرار. وفي الوقت الذي تراجع فيه التهديد الاقتصادي الياباني في التسعينيات، صعدت الصين بوصفها التهديد الأساسي الذي يواجه الرأسمالية الأمريكية في الأجل الطويل، وهو ما يشير إليه العديد من المفكرين الاستراتيجين الكبار في الولايات المتحدة.
ومع تأكيدات العديد من المحللين على وجود مثل هذا التهديد إلا ان البعض الآخر مثل مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس كارتر (1977- 1981) زبيغنيف بريجينسكي (Zbigniew Brzezinski) كان أكثر تشككاً في قدرة الصين على النمو لتصبح تحدياً حقيقياً للهيمنة الأمريكية، خاصة عندما ترتكز التنبؤات على "توقعات إحصائية ميكانيكية" حسب قوله. يعد Brzezinski أقوى من يعتقدون أن التحدي الذي يواجه الطبقة الحاكمة الأمريكية هو الحفاظ على قيادتها للدول الرأسمالية الغربية بالإضافة إلى بسط نفوذ هذه القيادة لتشمل القوى الكبرى الأخرى. إن النجاح الجيوسياسي الأساسي لإدارة كلينتون (1993 – 2001) يتمثل في بسط الهيمنة الأمريكية في "أوراسيا". وكان ذلك مهيئاً بفعل الخلفية الاقتصادية، حيث حظيت الولايات المتحدة بانتعاش شهد تصاعداً في أغلب عقد التسعينيات. في تلك الأثناء شهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال معظم ذلك العقد، فيما عانت اليابان من أسوأ أزمة انكماش تواجه دولة رأسمالية كبيرة منذ الثلاثينات. إن التحول النسبي في ميزان القوة الاقتصادية لصالح الولايات المتحدة دعمه اللجوء الانتقائي إلى القوة العسكرية من جانب إدارة كلينتون. إن الحملة التي قام بها حلف الأطلنطي على صربيا في عام 1995 والحملة الأوسع نطاقاً في كوسوفا في عام 1999 ساعدتا على تأكيد تبعية الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة واعتماد هذا الاتحاد على القوة العسكرية الأمريكية حتى في حل النزاعات التي تقع في فنائه الخلفي، في البلقان.
هذا مع العلم ان حرب البلقان في عام 1999 كانت بمثابة مناسبة لترويج آيديولوجية "التدخل الإنساني"، خاصة من قبل رئيس الوزراء البريطاني حينذاك (توني بلير Tony Blair)، من أجل تأكيد حق "المجتمع الدولي" (الذي هو في هذه الحالة الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيين) في تجاوز مفهوم السيادة الوطنية وشن حرباَ على الاقل من اجل معاقبة انتهاكات حقوق الانسان التي تقترفها "الدول المارقة".
ومن هذا المنطلق اتبعت إدارة كلينتون استراتيجية جديدة قائمة على التعددية بمعنى العمل المشترك، من خلال إعادة تأسيس الرابطة عبر الأطلسية من خلال إعادة بناء علاقة جيوسياسية متجددة مبنية على مبدأ القيادة (Leadership) الذي يقتضي أن تمتلك القوة المتفوقة مشروعية جمع الآخرين في منظومة جماعية، وحق المبادرة والسير بهم نحو غايات مشتركة، مع السماح لهم ودفعهم إلى لعب أدوار شراكة - مع تحمل أعبائها- تقف عند خط رفض كل حركية قد تؤدي إلى تهديد وضع التفوق ومكانة الريادة.
ان هذا الخط البراغماتي الذي أطلق عليه مفهوم "القيادة عبر الشراكة" (Leadership by Partnership)، يتضمن – بحسب مهندسيه - تحقيق ثلاثة أهداف أساسية:
- منع قيام قطب أوربي استراتيجي مستقل خارج الرابطة الأطلسية؛
- تشجيع إقامة هوية دفاعية أوربية داخل الإطار الأطلسي؛
- تحقيق شراكة أورو-أطلسية إستراتيجية في إدارة المصالح الغربية المشتركة في العالم.
وعلى الرغم من التأكيد على مسألة بناء التحالفات، فإن استراتيجية إدارة كلينتون كانت بعيدة عن أن تكون متعددة الأطراف. فقد كان العمل على توسيع حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي بمثابة وسيلة لتأكيد الهيمنة الأمريكية في "أوراسيا"، وليس بديلاً عن السيادة الأمريكية.
لقد بادرت الولايات المتحدة بشن "حرب البلقان" في عام 1999 تحت غطاء (حلف الناتو)، دون أي مرجعية من (مجلس الأمن الدولي). علما أن الولايات المتحدة تجاهلت الأمم المتحدة بالفعل حينما قصفت العراق في عام 1998 بمساعدة بريطانيا وآخرين.
وبشأن "استراتيجية الحرب الاستباقية"، فقد اختفت مع الفترة الرئاسية الاولى للرئيس (بيل كلينتون) أية مؤشرات على تفكير الاوساط المحدِدة للسياسة الخارجية الامريكية. و عادت هذه الرؤية للبروز في أوساط الادارة الامريكية مع حلول 22 أيار 1997 تاريخ بداية عرض ومناقشة تقرير "المراجعة الرباعية للدفاع" The Quadrennial Defense Review من قبل وزير الدفاع الامريكي آنذاك ويليام كوهين (William Cohen) امام الكونغرس. ثم اصبح وزير الدفاع في ادارة كلينتون ويليام بيري (William Perry) في 1 كانون الاول 1996 ملزما بإحداث هذا المجلس وهو ما تم فعلا.
وقد بدا واضحا أن التوجه الجديد اعتمد على رؤية "توازنية" (Equilibriste)، فبين التيار التدخلي، الهيمني الذي يريد من الولايات المتحدة أن تقوم بدور عالمي مهيمن، والتيار الانعزالي التقليدي الداعي إلى انسحاب الولايات المتحدة من مسؤولياتها العالمية المكلِفة دون مردود، اتجهت الإدارة الأمريكية الجديدة اتجاها يحاول أن يكون موفِّقا بين الاثنين، وبالتالي أكثر تكيّفا مع واقع وضعية الولايات المتحدة الذي يفرض عليها مسؤوليات عالمية قيادية دون أن تُطرح هذه المسؤوليات بالشكل المطلق، وفي الوقت نفسه يمكِّن الإدارة من الالتفات لمعالجة الوضع الداخلي، وهي المهمة التي كانت تقع على رأس قائمة أولويات الإدارة المنتخبة في نوفمبر 1992. وقد عبر كلينتون عن هذا التوجه في خطابه الموجه للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 27 سبتمبر 1993.
ويرى بعض المهتمين بهذه الاشكالية أن تبنِّي الإدارة الأمريكية خلال "حقبة كلينتون" لهذا الاختيار جاء نتيجة موازنات قادتها إلى النتيجة التالية: "إن سياسة خارجية مبنية على مبدأ الهيمنة العالمية سيكلِّف الولايات المتحدة ثمنا اقتصاديا باهظا، كما أن إتِباع سياسة مبنية على مبدأ الانعزالية التقليدية سيكلفها ثمنا سياسيا أكبر ".
"ولسونية براغماتية" (Pragmatic Wilsonism)، هكذا وصف المذهب الذي مثّل الخط الموجه الجديد للسياسة الخارجية الأمريكية لفترة ما بعد الحرب الباردة، والذي عثرت عليه إدارة كلينتون (الأولى و الثانية) واعتنقته بعدما انتفت مبررات بقاء مذهب الاحتواء.